بالعودة إلى التاريخ الوبائي للبشرية، فقد سببت الفيروسات الاصل في هذه الأوبئة، منذ ظهورها فجأة و إلى غاية إندثار البعض منها، الآلاف بل المئات و الملايين من الوفيات
لطالما كانت للبشرية، منذ بداية تدوين التاريخ، أو حتى قبل ذلك بالعديد من القرون، ذات علاقة غير طيبة مع الأوبئة، بيد أن البشرية لم تر في الأمراض و الأوبئة، على حد السواء شيئا من الايجابية، فقد كانت نظرتها لها على أساس العقاب الرباني أو من قبل آلهة في جل البلدان، نظرة سادت لدى عامة الناس، إلا لدى العلماء و الأطباء و أصحاب الاختصاص، الذين رأوا في ظهورها للعلن، نوعا من التحدي العلمي و المعرفي لهم، وتسابقوا كل من جهته و مجال عمله، على اكتشاف علاجات تمكن من القضاء عليها.
لا يختلف إثنان، على ما ذكرناه في الفقرة السابقة، فمع تطور التكنولوجيا و لاسيما الطبية منها، تعالت الاصوات لدى العلماء و الفاعلين في المجال الطبي، بقدرتهم على تجاوز اي تحدي تقدمه الطبيعة لهم، على غرار الاوبئة الأشهر فتكا على مر التاريخ، انطلاقا من الطاعون في القرون الوسطى، وانتقالا إلى «الأنفلونزا الإسبانية» في 1918، مرورا الى الكوليرا في 1983، وصولا الى فيروس» سارس» في عام 2013، وأخيرا الجائحة الجديدة فيروس كورونا في 2019.
فرض وباء كوفيد-19، نفسه شيئا فشيئا على المجال الطبي الدولي، وعلى شعوب العالم عامة، التي تعيش على اثر قوانين الحجر الصحي المنزلي، وهو إجراء لم يعهده سكان العهد الحديث، بيد أن غالبيتهم يعيشون روتينهم اليومي في حركة دائمة، توقفت فجأة وتزامنا مع مطالب منظمة الصحة العالمية، في التزام المنازل كإجراء وقائي، للحد من انتقال الفيروس المستجد بين الأفراد، أو لتجنب العدوى من المصابين، وحتى للتشجيع على الانعزال لمحاربة الفيروس ذاتيا، كون الشخص لا يملك إلا نظامه المناعي الخاص، كأداة للدفاع و الهجوم طبيعي، والتي توضع على كاهلها مهمة صعبة للغاية، تقتضي القضاء على الفيروس.
أجبرتنا الحالة الوبائية العالمية، وارتفاع أعداد الإصابات بشكل متصاعد، على غرار ما سجلته اليابان مؤخرا، من ارتفاع في الإصابات قارب 100 شخص في اليوم، و ما تعيشه دول أوروبا العظمى كإيطاليا و إسبانيا و فرنسا، من وفايات تتصاعد أرقامها بشكل مرعب في بعض منها، الى اتخاذ إجراءات وقائية متعددة وسهلة التطبيق، كغسل الأيادي لمدة 40 ثانية، وتعقيم الأسطح بالمواد عالية الكحول، أو التقليل من التحركات الخارجية، إلا أن هذه الإجراءات لم تسعف الأقل حظا منا، نخص بالذكر كبار السن و المصابين بالأمراض التنفسية، ليباغتهم الفيروس ويحرم أحباءهم و أقرباءهم من توديعهم، أو حضور مراسم دفنهم كما شهدنا في إيطاليا مثلا.
بادرت السلطات الطبية، في دول شتى حول العالم، لتطبيق اجراءات وقائية شبيهة بما يفرض على الاحياء، من المصابين بكوفيد-19 في حالاته المتقدمة او الحرجة، فارضة منع أولياء امور المتوفين و اقاربهم، من لمس المتوفي او الاقتراب منه، ناهيك عن مراقبته من بعيد عبر زجاج غرف التجميد، أو الصلاة على الميت جماعة بالنسبة للمسلمين، مهمة تكلف بها عدة أطباء و أطر طبية من المسلمين، عدم تجاوز مسافة المتر الواحد ما بين المتوفى و أقاربه. يضاف إلى ما سبق، وفي حال تواجد اقرباء الميت، ضرورة ارتدائهم لملابس واقية كالتي يرتديها الأطباء، وأقنعة للوجه و كمامات و نظارات للوقاية، قفازات أحادية الاستخدام، على ان لا يتجاوز عدد المتواجدين الشخصين.
في فرنسا مثلا، تم تأخير مراسم وداع المتوفي، بسبب الإجراءات الطبية الضرورية، لتجنب التلوث المحتمل و انتقال العدوى، من جثة المتوفى نحو مصابين محتملين، فقد اعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، بتاريخ 17 من مارس الماضي، بان الإجراءات المتعلقة بمراسم الدفن، تحد من عدد الحاضرين في الجنازة، لحدود 20 شخصا او أقل، كما أعقب رئيس الوزراء بالقول “نعلم انه امر صعب للغاية. ان الجميع يفتقدون القدرة لحضور جنازة أحد أقاربهم، بسبب الأجواء الوبائية الحالية، لكن يجب علينا ان نتحمل صعوبة الفراق، من أجل الصالح العام”. من جهة اخرى، وفرت بعض خدمات تحضير الجنائز في فرنسا، إمكانية البث المباشر لمراسم الدفن، كنوع من التعويض لعائلات المتوفين.
يصعب على العديد من الأشخاص، خاصة المرتبطين بوفاة أحدهم، في ظل الظروف الحالية، تخيل اقارب المتوفي وهم يلبسون بزة بيضاء، أشبه بما ترتديه الأطقم الطبية، في مواجهة جائحة كورونا المستجد، ناهيك عن تخيل الأرامل او اليتامى بهذه الألبسة، في جلسات لتنظيف خواتم الزواج أو هدايا الأطفال، في تجمعات محدودة لدفن احدهم، وذلك لأن طقوس الدفن و الجنائز، ليست لحظات تافهة او سهلة العبور، ولا علامة من علامات اللباقة التي عفا عنها الزمن، بل هي تجمعات تخدم أهدافا إنسانية، من أبرزها مكافحة الشعور بالحزن الشديد و الفقدان، تجمعات تعبر عن ”حزن الجماعة”، على حد تعبير أحد الاباء المؤسسين لعلم الاجتماع، إيميل دوركهايم (1858-1917).
*إن إحترام هذه الطقوس، أمر مصيري لأقرباء المتوفي، وضروري بعد وفاة الشخص، فلاشيء أخطر من لحظة موت “لم تمر مرور الكرام”*
في سنة 1912، وخلال انتشار الأشكال الأولية للحياة الدينية، ذكر إيميل دوركهايم على انه “لا يمكن اختزال الحداد في التعبير التلقائي عن المشاعر الفردية”، ويضيف “لاشك و في حالات معينة، أن الشعور بالحزن المعلن عنه يمكن الاحساس به من قبل الآخرين. لكن، و على العموم، لا توجد علاقة بين المشاعر المعلن عنها، و المعاشة من قبل الأشخاص، وبين الحركات التي يقوم بها، القائمون على الطقوس الدينية”. ويتابع “ان الحداد، ليس حركة طبيعية للأحاسيس الخاصة، التي تتكون بسبب الخسارة القاسية، بل هو واجب تفرضه المجموعة و المحيطون. نحن لا نأسف فقط لأننا حزينون، ولكن لأن علينا ان نرثى”.
بالنسبة لدوركهايم، ف”إن الغرض من الطقوس الجنائزية، تقريب الأفراد و توطيد العلاقات، وتعزيز الروابط بشكل اوثق، ومزامنتها مع الحالة النفسية السائدة”، أي ضمان الوحدة الأخلاقية للمجتمع، الحزين و المتألم لفقدان واحد من أفراده. ويتابع “بما أننا نبكي معا، فهذا يعني اننا مازلنا متمسكين يبعضنا البعض، وان المجتمع بالرغم من الضربة الموجعة التي تلقاها، الا انه لازال وقفا ومنتصبا. مما لاشك فيه، ان المشاعر الحزينة هي ما يتم تقاسمها بين الأفراد، وأنها مشاعر مشتركة. إن مشاركة الحزن، هو مشاركة الضمائر و ما تتضمنها، مع عدد قليل من الأشخاص، يعزز الحيوية الاجتماعية”.
اختبر أحد طلاب دوركهايم، «روبرت هيرتز» قبل وفاته، خلال صراعات الحرب العالمية الأولى، التمثيلات الاجتماعية التي تلهم الطقوس الجنائزية. في سنة 1970، خلال إحدى مساهماته، في دراسة حول التمثيلات الاجتماعية للموت، عبر مراقبته للطقوس الجنائزية غي اسيا، تحديدا تقليد “الجنازات المزدوجة” في اندونيسيا، مصرا على أنها ليست حقائق “محلية بحثة”. بعد الموت، كما يكتب، أن المجتمع يرى في الحداد “عمل مضنيا من التفكك و التوليف العقلي” لاستعادة السلام الداخلي.
بالنسبة لروبرت هيرتز، فإن الجنازة وما يليها من طقوس، لها هدف أساسي و ذو أهمية كبرى، يتمثل في إشهار الشخص المتوفي أو المفقود للمجتمع، وتحديدا المجتمع الحي، الذي يمثل مجتمع الأسلاف غير المرئي. يقول عالم الانثروبولوجيا، فريديريك كيك : “بعد الموت، يخاف الاحياء من عودة الاموات لمطاردتهم”، إن الهدف من الجنائز، هو ابعاد شبح الأموات، أي انها الفاصل بين عالم الاحياء و الأموات، من خلال تثبيت المتوفي في هذا المجتمع، بالتوازي مع مجتمعنا الواعي و الحي. إن الطقس الجنائزي، يحول الجثة البيولوجية الى كائن إجتماعي، بالرغم من انتمائه للعالم الآخر”.
لطالما انشغلت شعوب المعمورة، بالتخيل و التفنن في ما يلي الموت، ومصير الاموات بعد رحيل ارواحهم، إذ ان هذه المعضلة الفكرية، كانت كما لا تزال مصدر قلق فكري و طبي للاحياء، إذ يتابع فريديريك كيك قائلا “لقد اظهر المؤرخ «فانسنت غوسارت»، حلال زيارته للصين و مراقبته لطائفة “الطاويين”، تمسكهم ببيروقراطية حقيقية تجاه الأموات، حيث يؤمنون بأن للمتوفي، مكان يلزمه بعد وفاته، يشابه مكانته أثناء حياته ومشابها لما امتاز به. لقد خط الغرب أيضا، خريطته للعالم الآخر، تمكنه من الهروب من ازدواجية الجحيم و الجنة، تبناها و آمن بها مسيحيو العصور الوسطى، كما ذكر “جاك لو غوف” في كتابه “ولادة المطهر” (غاليمار 1981)، الذي يصف مجتمعا وسيطا، حيث يمكن للأموات، طلب المغفرة من بعض خطاياهم”.
يرى مؤلف كتاب “أصول طقوس الجنائز”، «إيريك كروبيزي» في تحول “الميت إلى فقيد”، مرورا عبر ثلاثة مراحل رئيسية. الأولى، ان ترى الجثة لكي تدرك حقيقة وفاة صاحبها، ما سيمكن من صنع ذكرى له، كمثال يمكن دفن جنرال ما، في ملابسه العسكرية أو يمكن دفنه ليظهر كما عهده احفاده. ثانيا، علينا إخفاء الجثة، سواء بدفنه أو حرقه، لأن هذا الكائن العجيب، الشبيه بالأحياء قد أصبح من العدم. وأخيرا، علينا تحويله، ومن الضروري ربطه بالتاريخ المعاصر، ودمجه مع تاريخ الموتى على العموم”، إن إحترام هذه الطقوس، يعتبر احتراما لمسار هؤلاء الموتى.
بالعودة إلى التاريخ الوبائي للبشرية، فقد سببت الفيروسات الاصل في هذه الأوبئة، منذ ظهورها فجأة و إلى غاية إندثار البعض منها، الآلاف بل المئات و الملايين من الوفيات، بيد أنها تفرض تحديات جذرية صعبة التحقيق في وقت قصير، من قبيل الإجراءات الصحية الجذرية، المتعلقة بشكل او بآخر بالخوف من العدوى، أي أن الاوبئة تغطي على تطبيق طقوس الجنائز، التي تنعكس بدورها على صحة العلاقات، بين الاحياء و الاموات. لقد برزت هذه العلاقة النمطية و الدنيوية، خلال القرن الرابع عشر، في فترة “الطاعون الاسود” الرهيب، وما نشره من رعب في اوروبا خلال خمس سنوات، ما بين سنوات 1347 الى 1352 ميلادية، عن مقتل ربع الى نصف ساكنة القارة العجوز بحسب التقديرات، الذين استسلموا لهذا الوباء الضخم المستورد من قبل المغول سنة 1330.
إن التعايش الطويل مع الموت، لاسيما في فترة “الطاعون الأسود” العظيم، يهز من قيمة الطقوس الجنائزية، ففي أوقات الوباء و الأمراض، يصبح الموت تهديدا مباشرا للحياة البشرية، وهو أمر لاحظه ووثقه، كل من الاستاذين ستيفان تزورتيس و كاثرين ريجيد، في دراسة بعنوان “استمرار أو تجاوز، للممارسات الجنائزية في أوقات الطاعون”، من كتاب “دراسات عن الموت، 2009”. فانطلاقا من تلك الحقبة، بدأت بعض الحواجز الاخلاقية و المقدسة، في التغير او الاندثار، بالرغم من العمل الدؤوب على حفظها، ولو بشكل جزئي للطقوس المرتبطة بالموت و الجنائز، التي قد يهمش بعضها لدواعي الضرورة، ومنه فإن التحركات الجنائزية، أصبحت متغيرة بتغير المجتمع.
فعلى سبيل المثال، وانطلاقا من القرن الرابع عشر فصاعدا، شهدت مقابر “المنكوبين” من أموات اوروبا، دفن البعض منهم دون توابيت خشبية، وغطيت جثث الآخرين بالمبيضات، للتقليل من الروائح و بواسطة أعوان النظافة، ودفن آخرون في مقابر جماعية، وعليه فقد توقفت عادة الدفن الفردي، كل هذه المسببات أدت في نهاية المطاف، الى اضطراب الممارسة العملية للدفن، كنتيجة مباشرة للزيادة المفاجئة في معدل الوفيات، في مواجهة مباشرة مع كارثة غير مسبوقة، استعان فيها سكان اوروبا، ببناء ما يعرف ب”مقابر الكوارث”، لتفادي نقل الجثث للشر الأسود، والتي تلقى في بعض الأحيان في الشارع.
*في مواجهة هذه المجزرة، وقلق المجتمع من الجثث، التي قد تصبح بؤرة الشر و منطلق انتشاره، بدأ المجتمع في تشييد ما يعرف “مقابر الكوارث”*
تذكر بعض المصادر التاريخية، أن مقابر تعود لسنوات “الطاعون الأسود”، تحديدا في القرن الرابع عشر، احتوت على رفات اكثر من 20 هيكلا عظميا، وهي تؤكد النظريات المتعلقة بعمليات الدفن الجماعي، وان اعداد الأموات كانت كبيرة جدا، ليتم التعامل معها جميعا دفعة واحدة. يبرز هذا الاتجاه، وتيرة متصاعدة و سريعة في عمليات الدفن، وهي بدورها تبرز تجاوز القائمين على قطاع الصحة في اوروبا، لبعض أو جل الطقوس الدينية المعتمدة في الجنائز. ففي فرنسا على سبيل المثال، فإن مدافن الأموات الحديثة، المعدة لضحايا الأوبئة، تتوفر على مدافن متعددة.
تمكنت دول اوروبا، منذ بداية القرن الثامن عشر، من تكوين حاجزها الطبي المنيع، امام زحف الموجات الوبائية الكبيرة، بيد ان وباء مارسيليا (1720-1722)، كان اخر حلقة في سلسلة الطاعون، التي قضت عليه التطورات الطبية و الدوائية، وظهور سياسات الصحة العامة تدريجيا، على غرار القضاء على وباء الجذري، في سنة 1820 من قبل “اللجنة المركزية للقاحات”، التي تأسست انطلاقا من تبرعات المحسنين، وكذلك الامر بالنسبة “للحمى الصفراء” و “التيفويد”، إلا أن أوروبا كانت على موعد مع موجة جديدة من الامراض، تحديدا في سنة 1826 التي ظهرت فيها بوادر “الكوليرا” بالهند، قبل أن تنتقل إلى روسيا، وتمر على بولونيا و فنلندا وألمانيا، ثم انجلترا و فرنسا، هذه الأخيرة التي سجلت بسبب «الكوليرا» في 1832، ما يقرب من 100 ألف ضحية، و 60 ألفا من «الأنفلونزا الروسية»، و ما بين 200 الى 300 ألف من «الانفلونزا الاسبانية».
شهدت فرنسا، خلال اجتياح «الأنفلونزا الروسية» لها، صعوبة كبيرة في تدبير جثث الأموات، في مدينة باريس على سبيل المثال، ففي غضون بضعة أسابيع، من اجتياح الوباء للمدينة، تحديدا ما بين 10 دجنبر 1889 الى 31 يناير 1890، سجلت المدينة قرابة 5 آلاف حالة وفاة، بحسب ما ذكره البروفيسور «فريديريك فانغرون»، الذي كرس رسالة الدكتوراه خاصته، حول أوبئة الأنفلونزا ما بين 1889 و 1918. تميز القرن التاسع عشر، بإنشاء مقابر خارج المدن، بغية الحد من تلوث التربة الزراعية، و تخفيفا من اكتظاظ المقابر الداخلية، وهي بادرة تحدثت عنها صحافة تلك الفترة، واعتبرتها احتراما لحرمة الأموات، خصوصا في سنوات 1918 و 1919، تزامنا مع أزمة «الانفلونزا الاسبانية»، التي قدر ضحاياها ب 400 شخص كل يوم.
بعد قرن تحديدا، ما بين سنوات 2013-2015، وتحديدا خلال أزمة وباء إيبولا، عاشت دول غرب إفريقيا نفس ظروف “الطاعون الأسود” بأوروبا، الامر الذي أدى الى تأخر طقوس الجنائز بها، خوفا من التلوث و التقاط العدوى من قبل الجثث، كون الفيروس ينتقل عبر اللمس، ما جعل السلطات الصحية تمنع أقارب المتوفين من لمس اجساد الضحايا. في مدينة «غيكيدو» على سبيل المثال، المتموقعة في دولة غينيا، بادرت السلطات الصحية المحلية، الى رش الجثث بمحلول الماء و الكلور، قبل ان يتم تغليفها في أكياس بلاستيكية بيضاء، ثم تودع في المشارح وتنقل للدفن في مناطق مجهولة، ولم يكن من حق العائلة أو الأقارب، سوى مشاهدة المتوفي من مكان بعيد أو عبر زجاج غرفة التشريح.
إن الممارسات الجنائزية، في غرب إفريقيا إبان إيبولا، لم تختلف كثيرا عن نظيرتها الأوروبية، خلال أزمة “الطاعون الأسود”، فقد تميزت كلا الممارسات و الطقوس، بعدم تقديم اي نوع من انواع الاحترام لجسد المتوفى، ففي الفترة ما بين ماي 2014 الى نونبر 2014، دفن المرضى المتوفون من جراء الفيروس، التابعون لمراكز علاج الوباء التي تشرف عليها منظمة “أطباء بلا حدود” الفرع البلجيكي، دفنوا في مناطق وأراض مجهولة، دون الاخذ في عين الاعتبار تسجيل مواقع الدفن، حيث وصف «فريديريك لو مارسيس»، في كتابه “الانثروبولوجيا و الصحة، طبعة 2015”، بان الجثثا لم تلقى المعاملة الواجبة من قبل الأحياء بشكل يليق بها، إذ أن هذه الوضعية تثير مشاعر الأسى و الحزن لدى أقارب المتوفي، وتحرمهم من أداء طقوس و شعائر مهمة بالنسبة إليهم، أي طقوس الأجداد القديمة، فقط لمنع انتشار الوباء على صعيد واسع.
انتقالا إلى سنة 2019، و الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020، واستنادا إلى التاريخ البشري مع الأوبئة، فإننا لن نلاحظ اختلافا جما، ما بين عادات الدفن في القرون الوسطى، أو في فترات الأوبئة الأوروبية، او حتى في فترات انتشار إيبولا، إلا أن الفيروسات التاجية كسارس او “كوفيد-19”، قد أبانت عن توحد في الآراء و الطقوس الجنائزية المتبعة، إذ يعود السبب في ذلك إلى وحدة الرأي الدولي، وتوحد الداء الذي أدى إلى هذه الوفيات، ناهيك عن تطور الفكر المجتمعي و التضامن الاجتماعي، وأيضا المساهمة التكنولوجية الحديثة، وما قدمته من تسهيلات لم يكن ليحلم بها سكان العصور الغابرة، أو حتى من عاصروا إيبولا او سارس. سعى النسيج الدولي، إلى توحيد فكرة “التكريم الجماعي”، والعمل على تطبيقها على المستوى الدولي، وذلك في مواجهة تداعيات كوفيد-19، التي غيرت شيئا من “النسيج التاريخي الجماعي”، بيد أن التكريم الجماعي سيساهم في دوره في مساواة الطبقات الاجتماعية، ومنه الحد من انتشار الوباء. ستعمل العديد من المدن، على الصعيد الدولي و المحلي، و لاسيما تلك التي خسرت عددا مهما من شيوخها، بعد انتهاء ازمة فيروس كورونا، على إحياء ذكرى أمواتها، بالشكل الملائم لتضحياتهم ورحيلهم، على غرار الاحتفالات التي ستقام في دور المسنين، أو تنكيس الأعلام على ارواحهم و لما لا تخصيص يوم وطني لهم.

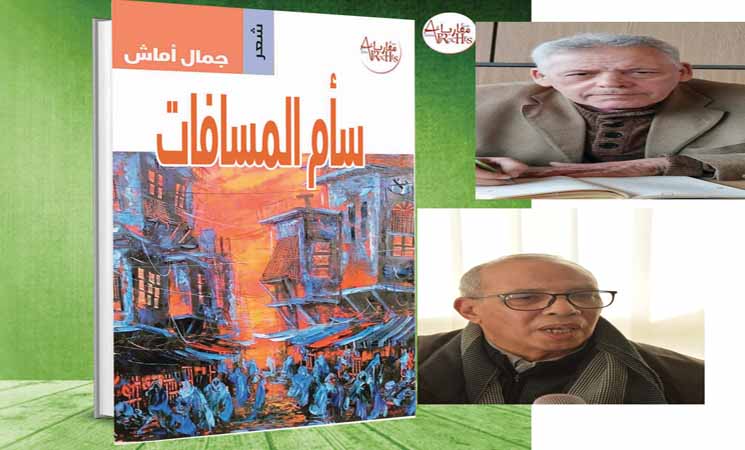




اترك تعليقاً