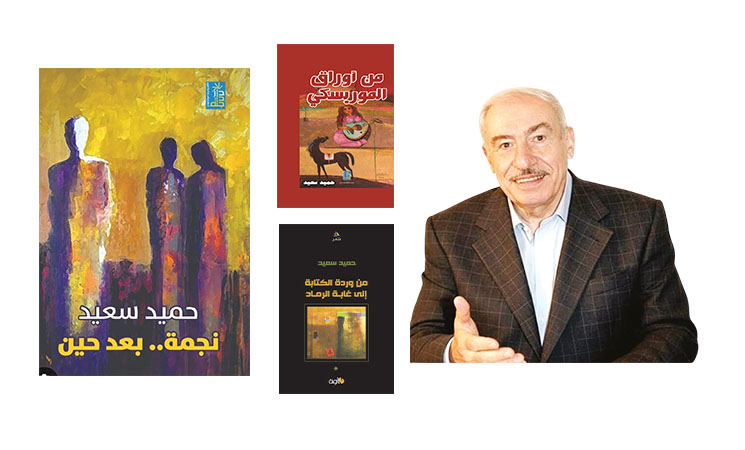تميز المهرجان العربي للقصة القصيرة جدا التي تنظمه جمعية الأنصار للثقافة بمدينة خنيفرة، بإفراد دورة هذه السنة، التي التأمت في الفترة ما بين 29 و31 دجنبر 2017، للاحتفاء بمنجز الكاتب والروائي والباحث الأكاديمي المغربي محمد أمنصور. وقد عرفت هذه الاحتفالية، التي تخضبت بلوينات الاقتسام والاعتراف والوفاء، تقديم عدد من الشهادات والإضاءات النقدية في تجربة وأعمال الأستاذ محمد أمنصور، باحثا ومبدعا وفاعلا جمعويا…
ـ 1 ـ
ينبغي أن أعترف أمامكم ،أولا، بأن العربية التي أكتب بها الروايات والقصص ليست لغة أمي.فأمي أمازيغية من جبال الأطلس المتوسط، هاجرت مع أبي بداية الستينيات من القرن الماضي إلى مكناس.في هذه المدينة الأمازيغية ـ العربية لم يكن من سبيل أمامها لتعلم العامية المغربية إلا استخدام أبنائها الذين يرتادون الزنقة و المدرسة ويختلطون بألسنة أخرى.هل تكون أمي هي المرأة الوحيدة من صنفها التي لجأت إلى هذه الحيلة كي تتعلم العربية ـ العامية؟وهل تكون أخطأت وهي تقلب معادلة «توريث اللسان الأمومي»(بدل تلقين الأمازيغية لأطفالها الستة جعلت منهم وسيلتها لتعلم العربية ـ العامية)؟في كل الأحوال؛علاقتي بالعربية الفصحى ـ كشأن كل أترابي وأبناء جيلي ـ جاءت من المدرسة،وسماع القرآن على لسان الأب الفقيه الذي نجح في انتزاع وظيفة ساعي بريد من جماعة الحركة الوطنية بعد الاستقلال. قبل ذلك، كان على وشك الحصول على شهادة العالمية من القرويين،لكن حرصه في مغرب الخمسينيات على تلبية نداء المقاومة المسلحة والالتحاق بصفوفها في جبال الأطلس،سيجعل من انقطاعه عن الدراسة يأخذ شكل تضحية بالمسار الشخصي(الحصول على الشهادة) من أجل استقلال الوطن.
أحيانا، أقول لنفسي لا يأتي الإنسان إلى الكتابة إلا من خلال سوء تفاهم كبير. أظن؛ تلك كانت تجربة جيل بكامله:محاولة فك التباس الانتماء اللغوي في خضم تقاطعات المحيط العائلي و التعليمي والاجتماعي والديني. أتخيل وضع الصبي المراهق الذي كنته،ممزقا بين ثلاثة ألسن: اللسان الأمازيغي الجاري في التواصل اليومي للأبوين داخل الأسرة. اللسان العامي الساري المفعول بين كل أعضاء الأسرة،بما فيهم الأبوان ،في الزنقة وفي كل مكان. اللسان العربي الفصيح، في المدرسة والراديو وتلفزة ذلك العهد. يتعلق الأمر بمنعرجات السبعينيات صعُودا نحو بدايات العقد الثمانيني من القرن الفائت؛فهل كان ممكنا لبذرة الكتابة بالعربية، بالنسبة لجيل من الكتاب ذوي الأصل الأمازيغي، أن تتشكل خارج قانون الهجنة؟
في البيت، يتغذى المتخيل الأمازيغي في وعي الطفل بتتبع حياة القبيلة الحاضرة الغائبة في أخبار و حمولات وقيم وعادات المرجعية الأطلسية التي تداوم اختراق تفاصيل الحياة اليومية للأسرة. يغذي هذا الرافد زيارات مكثفة لضيوف العائلة القادمين من”مغرب غير نافع”: عالم “اللا تنمية”، بحثا عن محاكم و مستشفيات مكناس. أضف إلى كل ذلك، زياراتنا في العطلة السنوية الصيفية المتكررة للجد والجدة في عمق الأطلس المتوسط مع نهاية كل موسم مدرسي،قبل رحيلهما الأبدي..
في الزنقة، ينفتح عالم الطفل الذي كنته لغويا ولهجيا على النبرات الصوتية والتلوينات المعجمية العامية لأطفال وصبيان آخرين منحدرين من أصول مختلفة (جبلية/ غرباوية/شمالية/سوسية…إلخ). يهيمن على كل ذلك، “أساليب التواصل الخاصة” بأبناء الدرب: (الهاوص)،تلك اللغة الاستثنائية التي تتكلف كل حومة باختراعها وتركيب معجمها من روافد لعب كرة القدم وسط الطريق، وشقاوات الشجار بين الأطفال، وبيع الزريعة بالتقسيط، والسرقة الجماعية لفواكه الضيعات المجاورة للحي. ينضاف إلى كل ذلك، الاحتكاك المتواصل بـــ “الصعاليك الكبار” لحينا”فورتينا”:كبار في السن والتجربة،صغار في عقولهم الشطارية،لا يتوقفون عن استعراض بطولاتهم الافتراضية بأشكال فرجوية أمام دهشة عيون الصغار: شرب الخمر وتدخين الحشيش. التباهي،ثم التباهي إلى حد الاستقواء بوقائع خرافية لا تحدث إلا في أذهانهم.أما إن كانت قد حدثت بالفعل،فلا قوة تستطيع محوها من ذاكرة حومة موشومة بفتوحات”الصعاليك الكبار”. الحصيلة: حكايات عجيبة مشبعة باستيهامات مبالغ فيها عن مغامرات جنسية وهمية تعزف على أوتار فحولة مكبوتة،وبطولة خارقة للعادة لا تكتمل إلا في الوهم والخيال!
في المدرسة، يتكفل أحمد بوكماخ ومحفوظات القصائد الشعرية العربية المنحدرة من تراث المشرق العربي بتسييج المخيال المدرسي ضمن ثوابت اللغة العربية والدين الإسلامي، ناهيك عن منظومة الأناشيد الوطنية وأصوات الشعر الوطني المنطلقة من أرجاء بلدان المغرب العربي، مع حفظ ما تيسر من سور القرآن.
البيت والمدرسة والحي، أضف إلى كل ذلك، الدور التحريضي للوالد ـ الفقيه السلفي الوطني تلميذ القرويين وأحد أبناء الحركة الوطنية الذي ظل يعد الفرنسية لغة العدو الكافر مهدد كيان أبنائه الستة؛ ما جعله يحرضنا بشكل متواتر على عدم إيلائها نفس الأهمية التي نوليها للعربية،فكان أن نجح في زرع نفور وجداني فظيع بيني وبين اللسان الفرنسي لم أشف من تمزقاته إلى اليوم.هل يكون محمد أومالك بهذا السلوك العدواني تجاه لغة الآخر،هو من دفعني إلى ركوب سفينة لغة الضاد؟. أليس هو صاحب نظرية: تعلم العربية في مقابل جهل الفرنسية؟ و هذه المفارقة العجيبة في التحريض المتناقض؛أليست هي سبب رسوبي في السنة الثالثة ابتدائي جراء ترتيبي الأول في مادة العربية، مقابل ترتيبي الأخير في مادة الفرنسية؟
ـ 2 ـ
هل المتخيل المغربي بالنسبة للكاتب بالعربية أو بغيرها في المغرب شيء آخر غير روافد العائلة، والقبيلة، والدين، والزنقة، والتلفزة، والمدرسة؟ قبل هذا وبعده؛ من يستطيع إغفال دور المحيط الجغرافي الذي يتفاعل فيه ومعه جسد الكاتب من الطفولة، فالمراهقة، فالشباب،فالكهولة… حتى الموت؟
عندما شرعت في كتابة قصصي الأولى ومحاولة تسلق جبل الرواية، أذكر؛ لم يكن ذلك إلا شكلا من أشكال البحث للخروج من مأزق الالتباس الناشئ عن وضعيتي اللغوية القلقة. لقد اكتشفت في فجر مراهقتي الفكرية أن كل الكتاب الذين أعشقهم وأتطلع إلى التشبه بهم والتماهي معهم (العقاد، طه حسن، سلامة موسى..) مشارقة عرب. فكيف لي أنا الأمازيغي أن أصير كاتبا،والحالة هذه،لست من أصول مشرقية ولا عربية؟فجأة،ومع فوران الحلم بالكتابة،انتصبت في ذهني نقطة سوداء تمثلت في اعتقادي أن لا انتماء إلى الكتابة وعالم الكتاب خارج الانتماء العرقي،العربي.إما تكون عربيا فتصير كاتبا،أو لا تكون.أصبت بالهلع: ما العمل وأنا دمائي أمازيغية:كيف القفز على محطة المشرق العربي كي أصير كاتبا؟ لم أعثر في محيطي على من يساعدني لفك لغز هذه المعادلة التي بدت لي مستحيلة.وأمام هذه الأسوار العالية،والأسئلة العالقة،ارتميت في تمارين الكتابة بالعربية علها تخلصني من شقوق اللسان وهجناته. أكثر من ذلك؛ أقنعت نفسي بأن الكتابة بالعربية،وحدها، ما سيحررني من أمازيغيتي التي صارت عبئا على موهبتي الناشئة.
سأكتشف،فجأة أنني أعيش أمازيغيتي في وسط ثقافي عروبي بوصفها عطبا وجوديا.أما الخلاص،فلن يكون غير اعتناق اللغة العربية كمدخل لتغيير الهوية. بهذا الشرخ الهوياتي الساذج على مستوى الوعي كتبت مجموعتي القصصية الأولى “أحوال” التي لم تر النور أبدا. لم نكن نستوعب نحن جيل الكتاب الأمازيغ المقبلين على الكتابة بالعربية كل أبعاد قلقنا الهوياتي بقدر ما كانت صعوبة الحصول على انسجام لغوي مع الذات ولها، بين القبيلة والمدينة، تحفزنا على مزيد من محاولات الكتابة. فهل انتهى اليوم هذا الوضع المركب؟ لو كان الأمر كذلك؛ هل كنت سأحتاج إلى مزيد من الكتابة؟
ـ 3 ـ
ما من إبداع إلا ويستمد متخيله من معطيات الهوية المركبة للكاتب، والفرق في تجربتي بين الأمس واليوم، ربما يكمن في سعيي المتواصل إلى تصحيح الوعي الشقي، المغلوط، المتمثل في الإحساس ب”الدونية العرقية” تجاه كتاب المشرق العربي،على وجه الخصوص. واستبدال كل ذلك بوعي إيجابي تجاه الذات قوامه المصالحة مع مكبوتها الأمازيغي المجسد لتاريخانيتها وجسدانيتها، بدل اجترار أوهام”اضطهاد ـ ذاتي” أفضت إليه التباسات الهجرة القروية والطفولة المنتزعة من الجذور.على أن العلاقة التي سأعيد تأسيسها باللغة العربية جعلتني أدرك أن لغة الأدب ـ عموما ـ لا يمكن أن تكون مجرد تعويض،ولا هي حجب لمكبوت لغوي وثقافي غابر.هي حفر وحفريات في آبار الذات الجمعية،هي سعي دؤوب للتحرر من العوائق والتغلب على الأعطاب الوجودية.العلاقة باللغة تكون تحررا وتحريرا للذات أو لا تكون؛إذ لا وجود لهوية غير متعددة أو غير مركبة، وتلك كانت خلاصة الخلاصات من هذا المسار الشاق. لهذا، أقول لكم: ليس ثمة أدب عربي في المغرب؛ بل أدب مغربي مكتوب بلغات العالم (العربية أو الفرنسية أو الإسبانية…) تشكل الأمازيغية واحدة من أركان متخيله، سواء أخذت شكل كتابة أو ظلت قابعة في الخلفية،تحرك المخيال بلغات أخرى. وإذا كان من الضروري إيلاء العنصر الجغرافي أهمية كبيرة في تشكيل المتخيل، فلأن تموضع الجسد الذي به نكتب يؤكد ذلك ؛ إذ رغم الانفتاح على مختلف الحساسيات الأدبية العالمية لا يمكن للكتابة أن تنشأ أو تتجذر خارج الجسد الذي يمشي على تراب جغرافي محدد. وجسدي الهش في بداية الثمانينيات من القرن الماضي عندما وعى أهمية الكتابة باليد لم يكن بمنأى عن الأوضاع العجائبية القاسية التي طبعت حكم مغرب ما سمي ب”سنوات الرصاص”. فهو في النهاية جسد بيولوجي،ولكنه ككل جسد مخترق بالثقافة والاجتماع والسياسة، ولو ظل المكون السياسي يغلب عليه الكبت ومستتبعات الدكتاتورية على الطريقة المغربية.
ـ 4 ـ
أعود لأطرح السؤال: كيف أكتب؟ أوكيف يكتب جيل من الكتاب الأمازيغ المتخيل المغربي اليوم، بالعربية؟
منذ النشأة الجنينية الأولى للرواية المغربية المكتوبة بالعربية، يمكن القول إنها قد استفادت، إيجابا وسلبا، من مدّي الحركة الوطنية و القومية العربية بدرجات متفاوتة. ولأن المد القومي العربي ،على مستوى التحقق في شكل أنظمة، قد انهار اليوم بالكامل مع فورة ما سمي ب”الربيع العربي”، ولأن إبدال “الدين السياسوي” ما يلبث أن يحجب إبدال “الوطنية المغربية” إن لم نقل يلغيها،فلعل التحدي الذي بات مطروحا على جيلي والأجيال الجديدة من كتاب اللغة العربية ذوي الأصول الأمازيغية هو الإجابة على السؤال التالي:إلى أي حد سننجح في جعل العربية ـ باعتبارها لغة لكتابة المتخيل المغربي، الأمازيغي وغير الأمازيغي ـ تتجذر في تربة الحداثة الأدبية بغض النظر عن كل الانتماءات امحلية،جهوية كانت أوقومية ـ دينية ضيقة؟
من هذا المنطلق،أتبنى «اللغة الروائية» بدل اللغة المعيارية: لغة النحو والصرف.فلا يوجد أي مانع لقدرة الكتاب المغاربة،أيا كانت أعراقهم ولغاتهم، على كتابة متخيلهم المغربي في تعددية روافده وتنوع مصادره بالعربية الفصحى؟ وإذا ما جوبه هذا الجواب بخرافة أن العربية لغة أموات لا أحياء، أو لغة مقدسات مشرقية تحاصرها المحرمات؛ فأي برنامج عمل أهم وأكثر إغراءا من ركوب التحدي والانخراط في مجابهة العوائق و الأعطاب الكامنة في آبار اللغة العربية:(الثقل الديني،المكبوت الوثني، المحظورات الأخلاقية، التراكمات الاجتماعية،المسكوكات والأعطاب السياسية التي تشكل جوهر اشتغال أي كاتب في منجم اللغة؟.
من جهة أخرى: لا مجال لفصل مشروع كتابة المتخيل المغربي عن مشروع تحديث العربية وجعلهما في علاقة شفافة باليومي والجسدي؟ فماذا يكون قد فعل الكتاب من أمثال محمد شكري ومحمد زفزاف وأحمد بوزفور والطيب الصديقي وغيرهم؛ غير إثبات إمكانية كتابة أدب حديث بالمغرب (قصة ـ رواية ـ مسرح) انطلاقا من»تامغرابيت»؟. طبعا،لم يكتب هؤلاء من فراغ. انطلقوا من المتخيل المغربي في تنوع روافده وتعدد مكوناته، و ساهموا في جعل العربية تحتل مكانتها بوصفها مكونا حداثيا من بين مكونات حقل ثقافي ـ أدبي مغربي غارق في الشفهي والفقهي والتقليداني. حقل غير واضح المعالم،لكنه صارم في رسم الحدود. هذا محمد شكري الأمازيغي يكتب باللغة العربية جاعلا سيرته الذاتية اختبارا لقدرة الأدب العربي على المتح من تجربة حياة جسد أمازيغي، الأمر الذي جعل منجزه يرتقي إلى مستوى التحقق بما هو لغة داخل اللغة: (لغة ومتخيل وقيم الهامش داخل اللغة. المعيار). ألم تنجح خطوته التحديثية تلك في إعطاء شكل أدبي للأصوات الأمازيغية واللغات الشعبية ونبرات الشارع والهامش بالعربية، مستمدا حيوية صوته الأدبي من تفاعل اليومي بالجسدي مع مختلف روافد المتخيل المغربي؟ العربية، إذن، بوصفها لغة كتابة للمتخيل المغربي لم ولن تكون في يوم من الأيام هي المشكل،ولا هي العائق أمام الكاتب المغربي كي يكتب نصه الأدبي الحديث، كما أن المقدس لم ولن يعوق العربية لكتابة النص الأدبي الحديث المحلوم به. العكس هو الصحيح: تستطيع العربية ،دائما، أن تتكلم داخل لغة المقدس باللغة الروائية أو الشعرية أو المسرحية أو السينمائية، ما يمنحها وضعية جديدة لا يتعارض فيها البشري مع المتعالي.
ـ 5 ـ
لا يمكن، إذن، فصل كتابة المتخيل المغربي بالعربية عن سؤال تحديث اللغة، ولا مجال لتحديث اللغة دون قبول الاختلاف والاختلاط والهجنة، فالمتخيل مركب ومتعدد ومتنوع شأنه في ذلك شأن الهوية. وإذا كان مسكن الهوية هو الجسد،وتموضع الجسد هو التراب ـ الجغرافيا؛ فماذا عساه يكون الإبداع في المحصلة النهائية سوى قدرة اللغة على مد الجسور بين تمظهرات الجسد وحقائق الجغرافيا. إن تاريخنا اللغوي في هذا البلد ليس تاريخا موحدا، ولا هو على نمط واحد. نحن شعب يتنفس ويتكلم و يكتب بلغات متعددة، وإن كنا شركاء في المعيش التاريخي الذي يغذي مخيالنا الجمعي كمغاربة. لكل هذا،سيظل مطروحا علينا،باستمرار، مشكل إضفاء الانسجام على فوضى واختلاط وتعدد مصادر المتخيل وروافده في أفق خلق النموذج الأدبي الذي نريد. ستستمر أوضاعنا اللغوية والثقافية حافلة بالتشرذم والثقوب والشروخ والتعقيدات والعوائق؛غير أن هذا الوضع لا يخصنا وحدنا،بل نتقاسمه مع كتاب آخرين في جغرافيات وأزمنة أخرى. وبما أننا لسنا وحدنا من يكابد معضلات الكتابة هذه،فلا يهم أن يكتب المغربي بالعربية أو الأمازيغية أو الفرنسية، بقدر ما يهمنا أن ينهض هذا الجسد الأمازيغي،العربي،الإفريقي من سباته الإبداعي.فما دام مسكن المتخيل المغربي هو الجسد والتراب،لا خوف من أي انفصال بين هذه المكونات.
هل يمكن للجيل الذي أنتمي إليه أن يزعم يوما أن لغته العربية قادرة على الانفصال عن مكونها الأمازيغي؟ سؤال حاولت الإجابة عليه إبداعيا من خلال روايتي الأولى «المؤتفكة» التي دمغ رؤيتها للعالم فضاء أمازيغي ومنظومة قيم ومحكيات اختزنها جسدي الأمازيغي فجاءت خارج قانون المماثلة مع عربية المشرق العربي. هي عربية لا تشبه في شيء عربية عباس محمود العقاد،ولا طه حسين ولا سلامة موسى بقدر ما تشبه عربية أمي؛ إن لم يكن في عاميتها ففي تلعثمها واختلاطها والتصاقها بالوجدان.
سقط وهم حتمية المرور من محطة المشرق العربي كي أكون كاتبا؛ وإذ أدرك اليوم سذاجة ذلك الكابوس،فإنني أستغرب لكل هذا التأخر في الإدراك:كيف احتجت إلى عقود كي أنتبه إلى أن أقرب طريق إلى العربية والكتابة الحداثية هو ببساطة أن أبقى مقيما في جسدي وأحيى حياة طبيعية مدموغة باليومي؟
أما أمي التي تقاسمت معي نفس الرغبة في تعلم العربية دون أن تنتبه إلى أنها بذكائها الفطري ذاك تكون قد حكمت علي ب»الحرمان» من رضاعة لغة الجذور.أمي التي حادت عن وصية الأسلاف في توريث اللسان للسلالة بينما هي منهمكة في جعل العربية صلة وصل بيني وبينها على حساب»اللغة ـ الأم».أمي التي جعلنا معا،هي وأنا، ولادتنا في العربية (الفصحى والعامية) تقترن بمقاومة «الاغتراب اللساني»في حومة فورتينا.هذه الأم التي امتلكت القدرة على المجازفة بطمس لغة الجذور هي نفسها،بعنادها وفضولها المعرفي، من سيضعني على سكة الكتابة لأخط اليوم ما أكتب وأنا في حل من لغتها الأصلية: (اللغة ـ الأم).أتكون بهذا «الفطام اللغوي» قد رفعتني إلى مرتبة آدم؟ أب البدايات وسرها،.ألم يرجع بي هذا الوضع إلى مقام من سيكون عليه تعلم الأسماء و اختراع الأبجدية؟
الثابت أنه ارتماء في المجهول. لكن؛ما المجهول؟في حالتي؛ليس شيئا آخرسوى الكتابة بغير لسان أمي!!