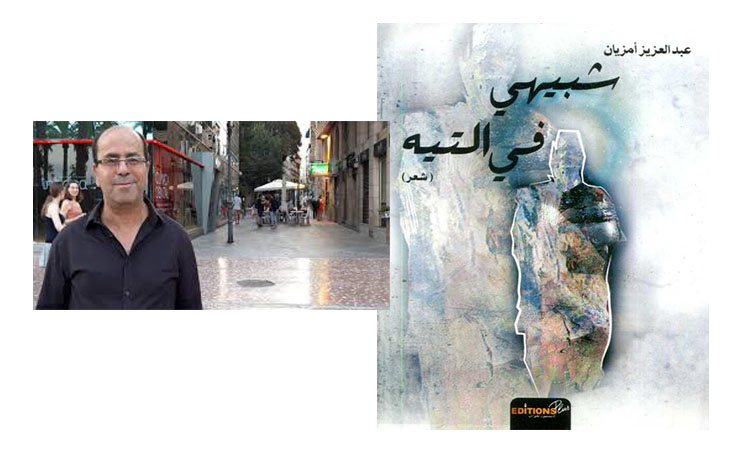في «التشظي» غربة تصهل، وانكسار يحدق بعينين جاحظتين، وألم شاهق وعميق، وبعض من ديموقريطس وهرقليطس، ودفق من الفلسفة :
(أ) قليل من الضوء .. كثير من الغربة في كل هذا الورق.
(ب) قل ذاتك وكافيءْ ألمك العظيم.
(ج) أعترف بعد العمر الطويل الخواء.. أني نجحت في أمر واحد: أن أجعل الفشل صديقا لي.
وفي التشذير جراحات مفلوقة ومفلوحة تنز دما، وحمحمة تقول الوجه المقيم مواربة ومداورة تارة، وجهرا فصيحا تارة أخرى، برغم أن الشذرـ كما يخبرنا «القاموس المحيط» هو: قطع من الذهب تلقط من معدنه بلا إذابة، أو خَرَز يفصل به النظم، أو هو اللؤلؤ الصغار. و»التشظي»: التشقق والتشتت. ومنه قول الشاعر القديم :
كالدرتين تَشَظّى عنهما الصَّدَفُ.
تأتلق الدلالة وتنشبك –إذن- حول النفاسة والثمانة والقيمة، والشعر صنيع هذه النفاسة، والشذرة درة في سبيكة الذهب التي هي الكتابة، واللُّمَع الهُمَع، من هنا أحقية التسمية، وتبلورها على صحيفة المسمى.
غير أن للدلالة قفاها أو وجهها الآخر.. وجهها المقلوب: تشظى القوم: تشتتوا، وتفرقوا شذَرَ مَذَرَ: ذهبوا في كل وجه. لكن بقليل من التفكير، ويسير من التَّعمُّل، بمُكْنَتنا عَدُّ الشذرات المتفرقات، والشظايا المتناثرات،لاليءَ المستحيل التي يجهد المبدع الصائغ –طوال عمره- في لملمتها بحنان وحماس أيضا لتنتظم في خيط نوراني لا مرئي، خيط الشعر والبهاء الماسي.
هذه التشظيات، والشذرات المحككة راودها عبد الحميد بنداوود طويلا (عشر سنوات) قبل أن تستكين إليه، ويستكين إليها حارثا ومحروثا. إنها شذرات مسكونة بالقلق والحكمة، صهرها في نار تجربته وقراءاته، وأكَبَّ عليها مثلما حداد يمددها حديدة ساخنة، ثم يقد أطرافها المتورمة، فلم يُبْقِ إلا على قالبها الأشهى الذي يرج العقل والروح.
في كتاب: «التشظي» إنصاتٌ رصينٌ لدبيب البشاعات وهي تزحف على ما تبقى من جمال في الكون، وتلتهم كالديدان المقززة عيون ميدوزا، واخضلال الأعشاب. وفي «التشطي» ضحكٌ فيوجه العالم الذي يخبط في الأوحال والمستنقعات كسلطعون أعمى. ولكنه ضحك كالبكا. يقول الشاعر: (ما بيدك أيها المسمار أن كانت المطرقة فوق رأسك تدق والخشب تحتك يشكي، ما بيديك يا صديق الكآبة.. أيها البرجوازي الضئيل !).
ثم يقول: (لماذا كلما رأيت حمار الشيخ، تذكرت وطني).
ويقول: (لو كنت ما زلت لم أولد بعد، وكان بيدي حق القرار، لقررت أن هذا الوقت ملائم تماما، ومناسب جدا لكي لا أولد !).
ثمة نوع من التماهي بين كتابة مصائر ومسارات منحرفة مقلوبة، وكتابة السيرة، سيرة الشاعر، وسيرة الأمكنة. وثمة نشيد أسود يطفح نياحة وعواء، عواء بالمعنى الذي يعطيه الشاعر الأمريكي آلانْ غنسبرغْ، للصراخ الحاد، والصفير في وجه القتامة والشر، كل هذا رغم ضوء الفرح الموارب.
هكذا هو الشعر: (في الرعب الأعمق، والقلق الأقصى، يحقق الشعراء ذواتهم، يحققون بمعنى آخر شعريتهم، ووجودهم الراسخ). هذه هي أطروحة «تولستوي» في موت: «ايفان ايليتش». يقول الناقد التونسي محمد لطفي اليوسفي في إشارة نبيهة: (الشعر إنما ينهض ليضطلع بأشد أدواره خطورة: الإشهاد على أن لا معنى للكائن خارج خساراته، والإشهاد على أن لا شيء كبر فينا، ومن حولنا، غير أحزاننا وفجائعنا ومحننا). من هنا، فإن عين بنداوود هي عين «أَرْميا» في مراثيه بمعنى ما. ثمة نشيد سري فادح، كما قلت، وجمرات ملتهبة مقصوصة على مقاس حمرتها، داحية الالتهاب إلى قرارة الألم، إلى قرارة الرؤيا رغم دثار الدعابة:
-يقول بنداوود: (وحده مفهوم المرأة يعضني.. أما المرأة كحقيقة مجسمة فإني أجدها أبدا بلا أسنان).
ـ ويقول: (وحدها أنهار الليل تعمق المجاري في دواخلي).
ـ ويقول: (كلما هممت بغسل هذا العالم في الماء إلا وألفيت نفسي مطوقا برعب هذا الاحتمال، أن أدنس الماء ولا يتطهر العالم !).
ومن جهة أخرى، ينحاز بنداوود إلى الشعر بمعناه الكشفي الومضي الذي يقول كلمته ويمضي. ويطرح بذكاء وحصافة وسخرية أيضا منظورة للكتابة على الإضمار لا على التصريح : (لكي تكون تقدميا يلزمك وضع استعارتك إلى جانب الأشواك المقهورة، وإعلان الحرب ضد امبريالية الورد).
في كتاب «التشظي» مَحْوٌ يَقِظٌ ومحسوب للزعانف والقشور والطحالب والإطناب. وفيه فخاخ للوعول والأيائل والجمرات، وصلصال الكينونة والحمإ المسنون، ودفء الرحم، والعري البهي. لغة الكتاب متقشفة عارية من الزخرف، والسيراميك والجلجلة البلاغية. لكنها لغة ناضحة بالتماع التجربة الشفقي، وعمق القراءة والامتصاص. إنها لغة تصر على أن تكون هي ذاتها رغما عن الأسانيد والمرجعيات. لقد انتصر الشاعر –وسط الزحمة- في شق طريقه الشخصي، ولونه، قصدت: دمه وضوء عذابه الخاص.
وتجاذبت الصورَ منازعُ حسية أبيقورية وسوريالية، مع احتفاء راسخ وناتئ بالمشاهد اليومية، وتقطير بديع لمشهد التأملات في سمتها الحكمي، وبعدها الفلسفي من خلل اشتغال المتناص داخل المتن، وهيمنته على المعاني الحافة سياقة وقيافة ورماية. هكذا يحضر أنسي الحاج وابن عربي، وبارط، وسبينوزا، وجويس، وفيثاغورس،والماغوط، في عجينة عجيبة، ونسج متداخل متراكب ومتضاد. يستدعي مواقف آنطولوجية، وسياقات تاريخية واجتماعية مختلفة ومتنوعة، ولكنها تنشبك في الأخير، لتضفي على الشذرات قيمة مركوزة، ومعنى مهيمنا. كذلك يتوالى إنتاج الدلالة من خلل رج المسكوك، والمتواطأ عليه باستعادة المعنى المثقوب، والغياب المفترى عليه بدعوى الانزياح الأكبر !.
إن ديوان «التشظي» يرد التسميات إلى صلصالها وإشراقها، إلى سمتها ووشمها ورسمها وأبواغها، ويكشط التعفن العالق بسرخسها !
والكتاب، كما أسلفت، شذرات هي عبارة عن ضربات فرشاة رهيفة وباذخة، لكن قاسية في رهافتها، ضربة «مْعَلَّمْ» على لفيفة زيتية أو لوحة زاهية قليلا، قاتمة كثيرا تعوم في الخسران !، ونسيج لغوي وَمْضيٌّ صمم بدأب عنكبوت، وعناد قطرب. ورغم حياديتها وبرودتها الظاهرة والمضللة، فإن الشذرات إياها، تنطوي على جراحات وخيبات، جراحات موشومة على جسد الكتابة، وأديم المقول، وخيبات عميقة الغور تسكن فروج الرؤيا، وشقوق السيرة. هي سيرة كتابة وحياة يتماهيان ثم يتقاطبان، يتجاذبان البوح المجروح، وفتات الأشياء وقبض الريح، وانكسار العلائق. إنها كتابة تبادهنا بالبداهة ذاتها كما تشكلت في رحمها الأول قبل أن تَتَزَعْنَفَ في كتب أخرى، بالتعاليم والافتاءات، وتتلفع بحراشف الاستعارة، وسُمْك الإغارة على المجاز والكناية، وحجاب الظن !!
في كل شذرة، استبصار واختراق والتماعات تقوم على روح وألق شعريين لا تخطئها البصيرة، وعمق معرفي حاضر كمنسأة ومتكأ تسندهما: (تجربة متفردة في الكتابة وفي الحياة معا) كما قال مصطفى المسناوي.
– يقول بنداوود: (يدي أطول من عمره.. يدي أقصر من يوم الجمعة وهو يستجدي أبواب المساجد).
-(الحياة حتى لكأن بذرتها أخطأت كل أسلافي !).
– (دفاعا عن الليل، أجدني أقص أجنحة النهار كي يطير سريعا).
– (أنا دائما أدق الباب، لكن أبدا لا تخرج الحياة لاستقبالي).
واقع الخيبات هذا الذي يصوره الشاعر في أسطر قليلة مختزلة، لكنها مضغوطة بالضوء ونسغ الحكمة، الليل حجاب- إذا ابتليتم بمعصية فاستتروا يقول الأثر، لكن الشرور تقترف في رابعة النهار، والشاعر مبتلى بتهشيم إبريق السَّفَلَة بالليل حيث تنشط جريمة اغتصاب الوطن، وتهريبه مكدسا ومكوّما في حاويات أو في إناث يُبَعْنَ على الأسلاك الوردية!
تحضر هذه المعاني ملفوفة في غلالات من الصور ذات طبيعة انتشارية وليس بلاغية بالمعنى القديم والمتآكل، معانٍ مؤسسة على مفارقات تعتمل في صلب الواقع، وقائمة على بنيات انشطارية متضادة في التلقي الأول، مؤتلفة في التأويل والإعراب، مستدعية جناحات ومقالب تركيبية عليها مدار الرؤيا، وولادة النواتج الدلالية المتنابذة ظاهريا، المتضايفة باطنيا:
-يقول : (الطائر الذي في العنق لا يحط على الأغصان إلا لكي تطير الشجرة).
-(في كل الحالات أو في كل الحانات ليس للمرايا ذاكرة).
-(في سيبيريا تتحول جهنم إلى ثلاجة ورحمة الله إلى قليل من النار).
-(حتى سيارة الإسعاف تحتاج إلى ميكانيكي !).
هذه الثنائيات الضدية تتشظى بدورها لتشكل نويات صغرى دورانها على تبئير الدلالة الكبرى التي عنوانها: السقوط المريع للأحلام، والانكسار المدوي للآمال. إن الكتاب / الديوان يلوذ بالخراب الجميل ! أو الحطام اليومي الذي يملأ الرحب، والقذى الذي يخدش العين. صور جارحة قاطعة في المعنى البادي والمحجوب، مسكونة بألم رهيف وقاس وإن بدت مدثرة باللامبالاة وبالدعابة، وبالقهقهة في وجه الأشياء العرجاء والمائلة، والعلائق المتغضنة، والحربائيين !.
تَتَنَاهَبُنا الشذرات ونحن نتقدم في القراءة: صور ترابية تقول ما ترى دون مساحيق وحذلقة، تظللها أليغوريا مدروسة ومخاطة بحذق الحرفي، فتسهم الكتابة بميسمها، بلاغتها في شفرتها واقتصادها وأبجديتها. مفردات قاموسية لكنها تجترح المتعاليات حين تلج بوابة الرؤيا، وتنهمر كالرذاذ الأليف أو كالخفيف :
– (الغروب: إنه الغرفة الجنسية لوصال الليل والنهار).
-(لماذا كلما ركبتني القصيدة خف وزني).
-(الناي لسان الصحراء بامتياز).
-(أي مبدع غيرك أيها الطفل، أي مبدع غيرك يرفع صوته عاليا في الطريق كي يكلم الحجر).
-(الطرقات لا تسير).
-(الرخام بحر ميت).
-(قليل من الضوء.. كثير من الغربة في هذا الورق..)
تقودنا الالتماعة الأدبية الأخيرة إلى الكتاب بما هو ذات وموضوع، بل أكاد أقول إنها حبل السرة، سرة «التشظي» لاعتبار يتمثل أساسا، في منطوق العنوان بما هو نص مواز، وعتبة تفتح العين والقلب لولوج المسكن / النص المذرروالمشذر لا المبعثر والمنتوف والمنفوش. إن «التشظي» يحيل –في العمق الدلالي- على التفرق والتشتت والانقسام، وفي المحمول والموضوع السياقيين، على ثقوب في الروح بعدد عيون الغربال !! بيد أنها عيون مقفلة أو عيون «كلاب ميتة» لا تترك سبيلا إلى انسراب الضوء، وما ينهمر منه على قلة وشح وتقتير إنما هو انفلاش وانفلات وتهميش لإبدال الحال برمانة الأمل، وسراب بقيعة!!
لذلك قلت في مكان آخر من هذه الكلمة –بأن الدلالة المهيمنة هي دلالة الخيبة والانكسار، وتتالي الإخفاقات والانهيار مما يفضي ويقود إلى الارتطام بصخرة واقع حرون، والنَّزْف على قرن ثور مخصي!. ومن ثم، الانكفاء والغربة بعد معركة شرسة غير متكافئة بين الشاعر والواقع: (عبثا تحاول أن تعطر المزبلة!).
وبرغم كل هذا، لانعدم في الكتاب / الديوان، كُوى ضوئية، ولُمَعَ نجوم، ووميضَ ابتهاج، ومنجزاً كتابياً ينم عن مكابدة، وصور منحوتة مشوية على نار هادئة تقول عذاب النار والنحات، وتربك حساباتنا، وخطية قراءاتنا المطمئنة الموروثة، وبالتلازم، تخلخل أفق انتظارنا فتأسرنا بخلاصة ضاجة بالمفارقة والشعر:
ـ (المرأة الوحيدة التي كانت تتلوى ليلا في سريرها الجامد.
فكرت في مؤامرة للإطاحة بالبرد، فأوقدت النار في نفسها
وقعدت تعوي طويلا أمام أرقام مذكرتها:
آه.. أوه.. أواه… آخ.. أواخ…
بدل أن تتصل بالمطافئ، اتصلت بي !)
كثيرة هي الإشراقات الحِكمية، ووفيرة هي الصور التي تنهض على التقابل والتضاد، والمفارقة التي صنعت هذا المقول الشعري الشذري المتلألئ في ناتجه العام، ومنحته سمته ونعته وعلامته المائزة. والحق أن من يقبع وراء هذه التشظيات الوضاءة، وهذه الفصوص/ النصوص المرتعشة كقناديل البحر في ليل الكون، لَقْلَقٌ حكيمٌ يقف في وحدته الخافقة داخل شواش مائي رهيب، يجمع المحار والقواقع باحثا عن لؤلؤة المستحيل على حد تعبير سيد بحراوي.
إن الصراع الأعتى، والقلق الأنطولوجي، والسؤال الأول الذي لا يني يتعمق ويتعملق كاويا ومؤرقا حول الوجود والانوجاد والكينونة داخل مجرة مقذوفة في السديم، وضمن اشتراطات فيزيائية ومورفولوجية ومجتمعية وميتافيزيقية، حتى الموسومة بالنقص والاختلال، هي مادة الشعر، منذ هوميروس، ومنذ ما قبل هوميروس، ومنذ ما قبل السبي الجماعي، ومنذ ما قبل النص البابلي الصاعق: (حينما في الأعالي). والشعر مُزَعْنَفاً بالحذلقة التصويرية، وموَشّى بالبديع البراني، ومُحَرْشَفاً بطبقات أو رقائق الاستعارة والمجاز، أو وَمْضيّاًشذرياً جارحا كرموش فاتنة، ناضحا باللهب كسبيكة في مقلاة الشمس، قَدَرُهُ هو أن يكون، أن يقول كلمته غير تَمْتامٍ، ولا مُرْتَعِد الفرائص، باعجاً أوزونَ القبح والبشاعة، وناخسا حمار الشيخ الحرون كما أشار إلى ذلك بنداوود.
هكذا يتكرس صوت شعري بيننا، صوت خفيف كشعاع، ثقيل بمعيار حمله المعرفي الذي يرفد هذه التجربة الكتابية المتفردة، هذه التجربة التي قال عنها الصديق الشاعر حسن نجمي: (إنها تكشف عن شاعر حقيقي يمضي سريعا وعميقا إلى ضوء الفكرة حين تلمع، ولا يستخف بالظل أو العتمة).