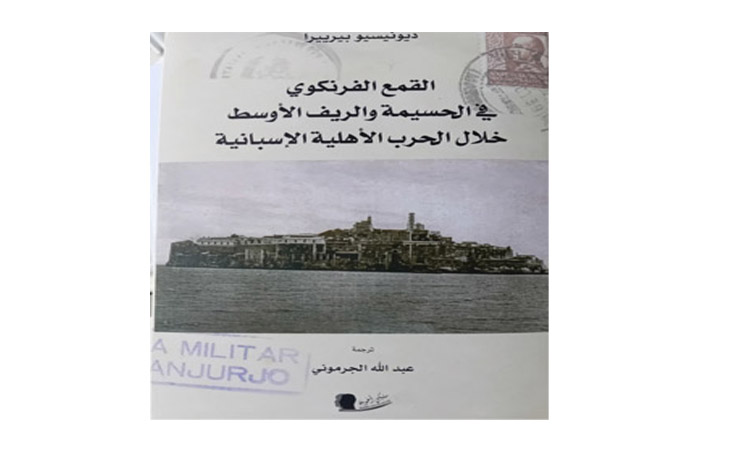تَفتحُ جَريدَة «الاتّحَاد الاِشترَاكي» عينَ القارِئ المَغربيِّ علَى فترَةٍ أسَاسية منْ عالَم الطُّفولة، يَسترجعُ فيهَا أَصحابُها لَحظاتِ عُبورهم الاسْتثنائِي مِن “عَالم الطَّبيعَة” إلَى “عَالم الثقَافَة”، عَبر اللِّقاء الأَوّل بعَالمِ الكُتّاب أوِ المَدرسَة وَمُروراً بمُختلَف الحكَاياتِ المُصاحبَةِ: الدَّهشَة الأُولَى فِي الفَصل؛ الاِنطبَاع الَّذي يُخلِّفه المُعلِّم أوِ «الفَقيه»؛ تَهجِّي الحُروفِ الأُولَى؛ شَغَب الطُّفولَةِ وَشقاوَتهَا وَأشكَال العِقَاب غَيرِ المُبرَّر أَو المُبرَّرِ بمَا لَا يُعقَل؛ انْتظَار الأمَّهاتِ أمَامَ بابِ المَدرسَة؛ زَمَن الرِّيشَة والدَّواة وَالقصَص الَّتي تسْتَتبِعُ لَطخَات الحِبْرِ في الأصَابعِ وعَلى الدَّفاترِ وَالمَلابسِ؛ مُقرَّرات الرَّاحلِ بُوكمَاخ الشَّهيرَة، وَغَيرِهَا منَ التَّفاصيل الَّتي كانتِ الْبدَاياتِ الأُولَى التِي قَادَتْهم إلَى مَا هُم عَليهِ اليَوم وَالَّتي بكلِّ تَأكيدٍ، سَتتحكَّم، قليلاً أوْ كَثيراً، في مَا سَيكُونُونَه غَداً.
حسبما أذكره، كانت المدرسة الابتدائية امتدادا منظما تنظيما آخر للحي. وكان القسم علبة حشيت فيها مع الأتراب. نعم علبة ضيقة. والإحساس العام الذي كان ينتابنا جميعا، على الأرجح، هو الإحساس بفقد شيء ثمين. إحساس كان ممزوجا ببعض الخيبة وكثير الهلع. كانت قلوبنا الصغيرة تدق بسرعة عند دخول القسم وتحية المعلم. وكان بعض الأقران ترتجف منهم الأطراف. وحتى الأشقياء من أولاد الحي كانوا يتسمرون على مقعد الطاولة، أصناما لا تتحرك منهم سوى الأعين. غير أني عشت تجربة أخرى قبل هذا…
لسوء حظي أو لحسنه رفض “عامس” الدرب أن يلحقني ب”الجامع” لأحفظ القرآن. لم يرفض مباشرة، بل اختلق الأعذار: اكتظاظ الجامع… تلعثمي في الكلام… وأشياء أخرى حكيت لي عني. كنت أسمع صراخ الصبية بالقرآن، وكان يفزعني ذاك الصراخ. وقرر أبي وأنا في الثالثة من عمري أن يلحقني بمدرسة «الأجرة»، ما يسمى بالتعليم الخصوصي. التي كانت على بعد عشرات الخطوات من منزلنا. كنت أصحب أبي إليها قبل أن يسجلني بها، حيث كان يحادث صاحبه المدير في أمور المقاومة والسياسة والحياة، وكان المدير، معلمي الأول، يحملني على ذراعيه وكأني ابنه ويضاحكني ويلاعبني ولا يلهيه ذلك عن متابعة الحديث والجدال..
بدأ الدرس يوما ما. وبدأت معه محنة المدير المعلم. لم أنضبط في عامي الأول، ولا في عامي الثاني. لم يكن سهلا على رأسي الصغيرة أن تثبت في المكان، ولم تمل على جسدي النحيف إلا أن ينحو منحاها. كنت دائم التيهان عن الدرس والمدرسة والعالم كله. كنت هناك في عالم الصور المعلقة، في الألوان، في الحركة، أتتبع كل من تحرك. أحس بالحركة أينما كانت. الأصوات كذلك كانت تثيرني. أصوات القسم والقسم المجاور. وضجيج الزقاق، ثم الروائح: رائحة غذاء المدير المعلم، إذ كان يسكن وأسرته بالمدرسة التي كانت منزلا، لا أكثر ولا أقل. رائحة الزبالين عند مرور شاحنتهم وصوت المزمار والصراخ، وروائح أخرى ملتبسة متداخلة منها بعض ضراط الزملاء والممحاة وجلد المحفظات ورائحة القطران أو الثوم على رؤوس بعضهم.
كان المدير المعلم يخرجني من تحت الطاولة، أو يحملني ويسمرني على المقعد كلما تمكنت من الزحف إلى السبورة الكبيرة السوداء على مرأى من حزمه في الدرس، ورحت ألعب بحتات الطباشير، أو تمكنت من الخروج من القسم الذي كانت بابه لا تغلق. كان يأمر ابنته الكبرى أن تمضي بي إلى السطح حيث بيته. كان ولا بد من أن يجد حلا. وكان الحل أن يعيدني بلطف إلى مقعدي أو ينادي ابنته كي تهتم بي بعيدا عن الدرس. لقبني المدير بالجني. كنت جنيا حقا. أو كنت ممسوسا، ولهذا رفض أن يحفظني الأحزاب، ربما…
أذكر المدرسة الأولى فأذكر السينما السريعة الصامتة. كان المدير المعلم يكتري آلة لإسقاط الأفلام ويمتعنا بمشاكسات شارلو ومغامراته. أذكر أني في أول عرض، أرعبتني تلك الشاشة المكهربة وعالمها الأبيض والأسود المتحرك بسرعة نزق. زد على هذا أن أزيز الآلة كان يزيد الحركة هولا، ناهيك عن الظلام، وخيالات الرؤوس والأجساد. أذكر أني بكيت، ولم أنته إلا حين أوقف المدير المعلم العرض، وأضاء حجرة القسم، ونادى ابنته كي تمضي بي إلى السطح.
أذكر المدرسة فأذكر كلب الجارة بائعة الحرقوس والحناء. كان وجهها تشينه الأوشام.. تقرأ الكف والحجر والأوراق. كانت تفزعني. وكان كلبها يلاحقني. وكانت عشرات الخطوات المؤدية إلى المدرسة جحيما. أبي كان عملاقا يحملني إلى الدرس وإلى الحديث إلى صاحبه المدير. كانت قبله شائكة وصوته يأتي من كل حدب وصوب.
كان علي أن أدخل مدرستي الأولى في العام الذي قضي فيه أن أختن. وكلب الجارة الذي كان يلاحقني ويسقطني على الأرض ويقف على رأسي نابحا. والدار التي كنت أتيه عنها، عند الخروج من المدرسة، فيلقفني أحدهم ويمضي بي إلى “دار الخليفة” فيقودني مقدم الحومة إلى البيت. لهذا ربما كانت أمي تربطني إلى باب الحجرة بحبل كي تتفرغ لشؤون البيت.
قضيت ثلاث سنوات خارج القراءة والكتابة، بالمدرسة، مقيما في عوالم شتى غير تلاوة بوكماخ التي كانت تصاحبني صورها ورائحتها. تلاوة السيد بوكماخ بأجزائها الخمسة كانت بحوزتي.. حاول المدير المعلم أن يعلمني بعض الكتابة والقراءة ولم يفلح.. كنت هناك في عالم الألوان والروائح والأشكال والأصوات. وكان أبي كلما أنهينا العشاء ورفع رأسه عن صندوق الراديو، جذبني إليه طالبا مني أن أقرأه المكتوب المصاحب للصور. وكنت أقرأ ما أراه بخليط اللغتين محاولا حكي الصور له كقصص بدارجة عالمة.
وقضي أن ازدان فراش الوالدين بوليد، وصادف ذلك رحيلنا إلى حي مجاور صارت معه المدرسة أبعد، ما أضاف إلى أبي هم العودة بي منها. كان إخوتي الكبار الممدرسون بالابتدائي يصطحبونني صباحا، وقبل الوقت إلى مدرستي. وكان يعجبني ذلك كثيرا، إذ كنت أصعد إلى بيت المعلم المدير، وأشاركه وأسرته وجبة الفطور، رغم فطوري في بيتنا. أما نهاية الدرس فكانت ألما كبيرا. كنت كلما تركت المدرسة جريت إلى بيتنا القديم وبكيت على عتبته؛ إنه لأمر غريب، حين كنت على خطوات منه كنت أتيه عنه، وحين ابتعد عني حفظت طريقه. كنت أجرجر أبي إلى تلك العتبة التي ما زلت أذكر زليجها. وكان لا يتعب ولا يغضب وأنا أتملص من قبضته كي أمضي إلى بيتي الأول جاريا باكيا
في سن السادسة كنت قد حفظت كثير بوكماخ دون أن يلتفت إلي أحد. كان القسم ومنذ البداية قسما مركب المستويات، من حين لحين كنت ومجموعة معينة لا بد وأن نلتزم الصمت كي يبدأ درس مجموعة أخرى. ولا أذكر كيف كانت تتداخل في رأسي المستويات.
حفظت كثير بوكماخ، في المنزل أيضا، إذ عند المساء كان يحلو لإخوتي الكبار أن يستعرضوا كثير الدروس ويقرؤوا كثير بوكماخ جهرا، وأنا حاضر بالانتباه غائب بشقاوة البدن، كنت أسجل وأحفظ وأرفض… نعم كنت أرفض أن أسمي الخراز إسكافيا، وأن أسمي الحانوت دكانا. لم تكن كلمة الحلزون لتعبر عن “الببوشة”، ولا كلمة الحلاق لتعبر عن الحجام… والكسال لم أجده في معجمي الصغير البوكماخي، وبائعة الحرقوس الشوافة.. وكلمة “عامس” أضحت معضلة.. كنت ببلاهتي أرفض كل هذا الالتباس..ثم إن صور التلاوة لم تكن تشبه العالم الصغير الذي كان يحيط بي، وكانت الكلمات غير الكلمات إلا قليلا. كنت أعيش بين العالمين، بين اللغتين وكأني زج بمقعدي بين مقعدين.
في السابعة من العمر، دخلت المدرسة الحكومية. كنت محفوفا برفاق الحي القديم والحي الجديد. ولم يكن يوم الدخول المدرسي بالنسبة إلي إلا كيوم عيد، وكنت أنزعج من الأطفال الذين يغيرون من سلوكهم أيام العيد، وكأنهم يرتدون مع ملابسهم الجديدة شخصيات مغايرة، وأزعجني المكان وأرهبني ببابه الكبير وساحته الكبرى وبنايته العريضة العالية، الكثيرة النوافذ، وسوره الذي يجعل منه حصنا منيعا.
كنت، منذ البداية، ربما، أحتمي بالبلاهة، لأني لم أفهم، ولا أفهم إلى يومي هذا، لماذا كان مقدرا علي أن أتعلم أسماء لا علاقة لها بالأسماء التي ولدت فيها ومنها وبها؟ لماذا كان علي أن أغتصب وأنا لا أكاد أناهز الثلاث سنوات، بكلام لا يشبه واقعي، ولا يعبر عن طفولتي، لا يفهمني ولا يحسني؟ لماذا كان علي أن أترجم به، وأصبح آخر؟ أو بالأحرى، أن يُوأدَ فيَّ نصف ليقحم في رميمهِ آخرُ غريب؟ لماذا كان علي أن أنجح في هذا الكلام وبه كي يقبلني محيطي ويعترف بي؟ لماذا لم أطالب بالنجاح في لغة ولدت بها منها وفيها؟ لم أفهم أبدا لماذا كان يعذب بعض المعلمين والمعلمات براءتنا، كي نحفظ النحو والصرف والإعراب؟ وكأنا لم تكن لنا لغة بنحوها وصرفها وإعرابها، نقتدي بقديمها، وبها نتعلم الجديد:
القط “مُشٌّ” في الواقع. وفي رأسي؟ منذ البداية رأيته بلغتين، منذ البداية لم يكن لي مكان إلا بين مقعدين… كان هذا إحساس طفل مصاب بعسر القراءة والكتابة ولا يحمل، طبعا، أية خلفية تنتصر للغة الدارجة…