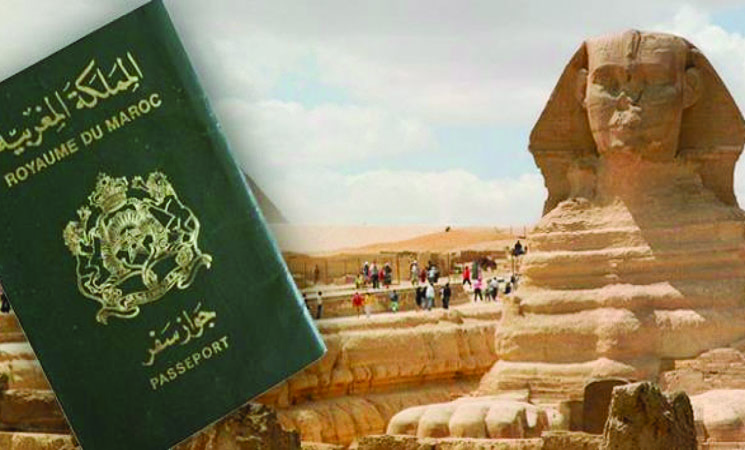وثيقة حول المغاربة
المقيمين بالخارج
في سياق التحضير للمؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وفي إطار الدينامية التنظيمية والفكرية الرامية إلى تطوير الوثيقة السياسية وتجديد قراءتها للقضايا الكبرى، تندرج أشغال لجنة قضايا مغاربة العالم باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من رؤية الحزب الشاملة، ورافداً حيوياً من روافد التنمية المتعددة الأبعاد داخل الوطن.
لقد شكلت قضايا مغاربة العالم، منذ سبعينيات القرن الماضي، إحدى الأولويات الثابتة في خطاب الحزب وممارسته، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية التي دفعت أعداداً كبيرة من المواطنين إلى الهجرة، بحثاً عن فرص عيش كريم ومساهمة فعالة في دعم أسرهم ووطنهم. وقد رافق حزب الاتحاد الاشتراكي هذه الفئة من أبناء الوطن في مختلف محطاتها، سواء من خلال المواقف السياسية أو الاقتراحات المؤسسية، أو عبر انخراط مناضليه وتنظيماته بالخارج في الدفاع عن مصالحهم الحيوية وعن القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحزب قد تبنى قضايا مغاربة العالم ضمن برنامجه الانتخابي، باعتبارها إحدى دعائم رؤيته التنموية، وشدد على ضرورة بلورة سياسات عمومية شاملة، تؤمن لهذه الفئة حق المشاركة والمواكبة والتأثير في حاضر الوطن ومستقبله.
ورغم تعدد الأزمات الدولية، ما تزال الهجرة من الجنوب إلى الشمال أحد أبرز مظاهر اللا تكافؤ في الفرص، حيث تواصل فئات واسعة من المواطنين المغاربة البحث عن شروط حياة أفضل في بلدان الاستقبال. ولعل تجربة المغاربة في أوروبا، منذ بدايات القرن العشرين، تبرز هذا المسار الذي بدأ بتلبية حاجيات اقتصادية لدى تلك البلدان، وتحول لاحقاً إلى واقع اجتماعي مركب يتداخل فيه البعد الاقتصادي بالثقافي والهوياتي والسياسي.
وتشكل فئة مغاربة العالم اليوم التي تمثل حوالي 14% من ساكنة المغرب، قوة بشرية ذات تنوع مهني وثقافي غني، راكمت عبر الأجيال إمكانات معرفية ومهارية معتبرة، تُعد رصيداً استراتيجياً للدولة المغربية في مسارات التنمية والدبلوماسية الموازية. وقد حافظت الجالية على ارتباطها القوي بالوطن الأم، ونقلت هذا الارتباط إلى أبنائها، من خلال التربية على القيم الوطنية والانتماء الهوياتي.
وتبرز أهمية مغاربة العالم، كذلك، في مساهماتهم الاقتصادية المباشرة، إذ تمثل تحويلاتهم أكثر من 7% من الناتج الداخلي الخام، وتعد مورداً رئيسياً للعملة الصعبة. لكن القيمة المضافة الحقيقية لهذه الفئة تتجلى في الطاقات والكفاءات التي تحتضنها بلدان الإقامة، والتي تمثل أكثر من 10% من الجالية، وتتموقع في مواقع استراتيجية داخل مؤسسات القرار السياسي، والبحث العلمي، والمجال المالي، والاقتصاد الرقمي، والقطاع الخاص.
وأمام هذه المعطيات، يبرز الدور الحيوي الذي تضطلع به التنظيمات الحزبية للاتحاد الاشتراكي بالخارج، في ربط جسور التواصل مع الجالية من جهة، والانخراط في النقاشات السياسية والدفاع عن المصالح العليا للوطن من جهة أخرى. وقد ساهمت اللقاءات التي عقدها الكاتب الأول مع عدد من فعاليات مغاربة العالم، في دعم هذا الحضور، وخلق دينامية متميزة تجسدت في إعادة هيكلة وتأسيس فروع حزبية بعدد من الدول، مما عزز تموقع الحزب كفاعل سياسي ملتزم بقضايا الجالية.
وفي السياق ذاته، يواصل الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية داخل البرلمان، حمل هموم مغاربة العالم، واعتبار قضاياهم من بين أولوياته في العمل التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية، من خلال تقديم العديد من المبادرات التشريعية ومساءلة السياسات العمومية والقطاعية، بهدف تحقيق العدالة والنجاعة والإنصاف لهذه الفئة من المواطنين التي تكتسي أهمية خاصة.
إن هذا الواقع المتقدم لمغاربة العالم يطرح على الحكومة المغربية تحدياً حقيقياً بخصوص فعالية السياسات العمومية في هذا المجال، ومدى قدرتها على الاستجابة لانتظارات الجالية، وتعزيز ارتباطها بالمؤسسات الوطنية، وتطوير الأطر القانونية والمؤسساتية لمواكبتها، بما يضمن لها الحماية، والتمكين، والمشاركة في التنمية، والتواصل الدائم مع الوطن الأم.
طموح التغيير مقابل جمود التنفيذ
الجالية المغربية المقيمة بالخارج في صلب الرؤية الملكية:
لا شك أن قضايا المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج حظيت بمكانة بارزة ضمن أولويات المؤسسة الملكية، بما يعكس رعاية خاصة وحضوراً مستمراً في الأجندة الوطنية. فقد تم تناول موضوع الجالية المغربية في ثماني خطب ملكية خلال أعوام 1999، 2005، 2006، 2011، 2015، 2016، 2022 و2024، وهو ما يترجم استمرارية الاهتمام بهذه الفئة على مدى ربع قرن. كما تجسد هذا الحرص في مبادرات عملية، أبرزها الإشراف الملكي المباشر على عملية “مرحبا” وتكليف مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمهام استقبال ومواكبة أفراد الجالية أثناء مقامهم وعند عبورهم نحو أرض الوطن، بما يعكس رؤية استراتيجية تعطي لبعد الهجرة مكانته في السياسات العمومية..
ويتأكد الاهتمام الرسمي بمغاربة العالم من خلال الحرص على إدماج قضاياهم في صلب السياسات الحكومية. حيث شكّل إحداث كتابة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون سنة 2002 خطوة نوعية أعادت الاعتبار للجالية المغربية عبر إرساء قناة مؤسساتية للتواصل معها وتطوير الروابط مع مختلف مكوناتها عبر العالم. كما شكل إحداث المجلس الاستشاري للجالية المغربية المقيمة بالخارج سنة 2007 آلية دستورية مهمة لتعزيز هذا التوجه، باعتباره أحد أهم المجالس الاستشارية في المملكة، حيث جمع ضمن بنيته التنظيمية – على مستوى الرئاسة والأمانة العامة والعضوية – شخصيات وفعاليات تمثل أجيالاً متعددة من الجالية، بما أضفى على التجربة بعداً تشاركياً يربط السياسات الوطنية بانتظارات المهاجرين.
لقد جرى إرساء المجلس الاستشاري للجالية المغربية المقيمة بالخارج وفق مقاربة تراعي البعد التمثيلي والتنوع المجالي، حيث شمل التوزيع الجغرافي لمغاربة العالم في أوروبا وأمريكا وإفريقيا والبلدان العربية، مع الحرص على ضمان حضور اليهود المغاربة ضمن تركيبته، بما يعكس الطابع الجامع للهوية الوطنية.
وفي السياق نفسه، شكّلت سنة 2007 محطة مؤسساتية بارزة، إذ تم الارتقاء بتمثيلية قضايا الجالية داخل الجهاز التنفيذي عبر تحويل القطاع من كتابة دولة إلى وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلفة حصراً بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج. هذا التطور رافقته دينامية برمجية تمثلت في اعتماد مخطط خماسي (2007-2011) يستجيب لانتظارات الجالية على المستويات الاجتماعية والثقافية والتربوية، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات الإدارية، وتوفير المرافقة القانونية، وتعزيز الدعم الإداري لفائدة مختلف فئات المهاجرين. كما أولى المخطط عناية خاصة بالبرامج الاستعجالية في بلدان عربية وإفريقية مثل الجزائر وليبيا والكوت ديفوار، مستهدفاً دعم الأوضاع التربوية والاجتماعية وتقوية الروابط بالوطن، ولا سيما فيما يتعلق بترسيخ الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة.
كما انصبت الجهود العمومية خلال هذه المرحلة على تثمين وتعزيز الروابط الثقافية والهوياتية للأجيال الصاعدة من مغاربة العالم، خصوصاً بلدان المهجر بأوروبا وأمريكا الشمالية وكندا. وقد جرى تحقيق ذلك عبر سلسلة من المبادرات المنتظمة، مثل تنظيم الجامعات الصيفية والمخيمات والملتقيات ذات الطابع الثقافي المختلط إلى غيرها من الأنشطة..، والتي أتاحت فضاءات للتفاعل بين الشباب المهاجر ومحيطه الوطني. كما تم إطلاق مشروع المراكز الثقافية “دار المغرب” بعدد من بلدان الإقامة، في خطوة استراتيجية تروم توفير بنية مؤسساتية دائمة قادرة على صون الهوية المغربية ونشر القيم الوطنية في بعض بلدان الإقامة.
كما تميزت هذه المرحلة بإرساء مرتكزات البرنامج الوطني الموجه لمغاربة العالم، من أجل توفير مقاربة شمولية لهذه الفئة. وقد ساهم البرنامج في إحداث تعبئة واسعة وسط أجيال الجالية، مكنته من إجراء تشخيص معمق لاحتياجاتها المتعددة وتطلعاتها المتجددة. كما أتاح المجال أمام الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج للانخراط الفعلي في تطوير السياسات والبرامج العمومية الموجهة لهم، من خلال تعزيز جسور التواصل مع المؤسسات والقطاعات الحكومية المختلفة، بما أضفى على مساهمتهم بعداً تنموياً وتضامنياً يربطهم بمناطقهم الأصلية في المغرب، ويحول طاقاتهم إلى رافعة لخدمة التنمية الوطنية.
وتميزت هذه المرحلة أيضا، بالاهتمام بإبراز المكون العبري داخل الجالية المغربية، من خلال تنظيم أنشطة ثقافية وتواصلية مع اليهود المغاربة المقيمين ببلجيكا وهولندا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. وقد عكست هذه المبادرات حرص الدولة على ترسيخ البعد التعددي للهوية الوطنية، عبر إبراز روابط المواطنة التي تجمع اليهود المغاربة بوطنهم الأم، كما أبرزت هذه الأنشطة مستوى التشبث بالتراث والثقافة والتقاليد المغربية الأصيلة، وهو ما يمنح التجربة المغربية خصوصيتها في صيانة التعدد الثقافي ضمن وحدة وطنية جامعة.
الحقوق الدستورية للجالية المغربية المقيمة بالخارج:
يشكل دستور 30 يوليوز 2011 محطة نوعية في مسار إدماج قضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج ضمن المرجعية الدستورية، إذ أفرد لها مجموعة من الفصول التي تؤطر حقوقها وتحدد آليات مشاركتها في الحياة الوطنية. فقد نص الفصل 16 على التزام الدولة بحماية حقوق ومصالح مغاربة العالم المشروعة، في احترام للقانون الدولي وللتشريعات الجاري بها العمل في بلدان الإقامة، مما يعكس رؤية مزدوجة تقوم على صون الحقوق وتعزيز الاندماج في مجتمعات الاستقبال. أما الفصل 17، فقد كرس مبدأ المواطنة الكاملة، بمنح أفراد الجالية حق التصويت والترشح في الانتخابات الوطنية والجهوية والمحلية، وهو ما يؤسس لمقاربة شمولية للمشاركة السياسية. كما جاء الفصل 18 ليؤكد على ضمان انخراط واسع للجالية في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة، بما يتيح توظيف خبراتها وإسهاماتها في مسار التنمية الوطنية وتعزيز الروابط مع الوطن الأم.
إضافة إلى ذلك، أقرت الوثيقة الدستورية حق مغاربة العالم في تقديم العرائض والملتمسات، باعتبارها آلية ديمقراطية تشاركية تعزز مكانتهم في صناعة القرار العمومي. ونص الفصل 163 على الدور المحوري لمجلس الجالية المغربية بالخارج، من خلال إبداء الرأي حول توجهات السياسة العمومية المتعلقة بالمهاجرين، بما يضمن الحفاظ على هويتهم الوطنية وصيانة مصالحهم، مع جعل مساهمتهم رافعة للتنمية البشرية والمستدامة وتقدم المغرب.
بين الإرادة العليا للبلاد والتنزيل الحكومي، إشكالات معلقة:
رغم المكاسب التي تحققت بفعل التوجيهات الملكية والبرامج الثقافية والاجتماعية الموجهة لمغاربة العالم، برزت إشكالات متعددة تكشف عن فجوة قائمة بين الإرادة العليا للبلاد ومستوى التنزيل الحكومي. فمن جهة، استفادت أجيال مختلفة من الجالية في المهجر من تظاهرات وأنشطة ثقافية وتربوية واجتماعية سواء بالوطن الأم أو في بلدان الإقامة، غير أن ذلك أفرز حاجات جديدة تتطلب معالجة أعمق من قبل السلطة التنفيذية والمؤسسات الاستشارية المختصة. ويأتي في مقدمة هذه الحاجات توسيع نظام الحماية الاجتماعية ليشمل المهاجرين في فضاءات خاصة، مثل دول الخليج وإفريقيا، وإحداث أنظمة تعاضدية موجهة للفئات المهنية العاملة في المهن الحرة.
ومن جهة أخرى، يطرح واقع بعض الفئات الهشة تحديات ذات طابع إنساني واجتماعي ملح، وعلى رأسها وضعية المسنين من قدماء المحاربين المقيمين بفرنسا، أو الأطفال غير المرافقين في إيطاليا وإسبانيا، إضافة إلى النساء المهاجرات رفقة أبنائهن. ففي بعض هذه الحالات، إذ يؤدي تدخل مصالح الرعاية الاجتماعية ببلدان الاستقبال إلى نزع الأطفال من أسرهم بدعوى هشاشة الوسط الأسري، مما يترتب عنه آثار نفسية واجتماعية عميقة على الأمهات والأبناء على حد سواء، بل ويزيد من احتمالات فقدان هؤلاء القاصرين لارتباطهم بالهوية المغربية نتيجة تبنيهم من قبل أسر بديلة في بلدان المهجر. وهو ما يستدعي مقاربة حكومية ومؤسساتية شمولية، قادرة على مواجهة هذه الإشكالات بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويصون الهوية الوطنية للأجيال الصاعدة.
هذه الإشكالات المستعصية تفترض تكثيف الجهود مع جمعيات وفعاليات مدنية، لمواكبة الجالية وتعزيز فرص الاندماج الجيد، من خلال تنفيذ برامج سنوية تُعنى بالمجالين الثقافي والتربوي، وتقوية المواكبة الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الموجودة في وضعية صعبة، من قبيل السجناء، والأطفال غير المرافقين، والمسنين، والنساء المهاجرات، بهدف تعزيز فرص إعادة التمكين الاجتماعي، ومحاربة العزلة والهشاشة الاجتماعية التي تعاني منها هذه الشرائح.
فبعد عقد كامل من الدينامية التي ميزت المرحلة الأولى لبناء سياسة عمومية موجهة لمغاربة العالم، برزت مرحلة ثانية اتسمت بالتراجع والركود. فقد اختارت الحكومة الحالية – المكونة من تحالف حزبي ضيق النفَس – إدماج القطاع المكلف بالجالية ضمن هيكلة وزارة الخارجية، بدعوى تسهيل التنسيق. غير أن هذه الخطوة لم تحقق الأهداف المعلنة، إذ سرعان ما تحولت البرامج إلى مجرد نصوص مؤجلة التنفيذ، وتراجع زخم المبادرات إلى حدوده دنيا، فيما فقدت الجالية مخاطباً فعلياً داخل الجهاز التنفيذي، على الرغم من استمرار رصد نفس الاعتمادات المالية في الميزانية السنوية.
وقد انعكس هذا الوضع في تجميد أو تعثر معظم الأنشطة والبرامج التي كانت تتيح فضاءات للتفاعل بين مغاربة العالم ووطنهم الأم، ما أفرغ السياسة العمومية من مضمونها العملي. هذا التعثر استدعى التدخل الملكي المباشر من خلال خطاب ثورة الملك والشعب لسنة 2022، الذي سلط الضوء على أوجه القصور البنيوي والإكراهات التنظيمية التي أعاقت التنزيل السليم للاستراتيجية. ويأتي في مقدمة هذه النواقص ضعف الأداء القنصلي ومحدوديته في الاستجابة لانتظارات المغاربة بالخارج، حيث لا تزال الخدمات القنصلية – رغم كونها الواجهة المباشرة للدولة – تعاني من بطء المساطر، وتفاوت الجودة، وغياب مقاربة قريبة من المواطن.
إن هذا التراجع يفسَّر بغياب رؤية حكومية مندمجة تعترف بخصوصية قضايا الهجرة، وتتعامل معها كملف استراتيجي متعدد الأبعاد (اجتماعي، ثقافي، حقوقي واقتصادي)، وليس كمجرد امتداد تقني لعمل الدبلوماسية التقليدية. وهو ما يفتح النقاش حول الحاجة إلى إعادة الاعتبار لهذا الورش، من خلال الإسراع بإحداث إطار مؤسساتي مستقل وفاعل، قادر على بلورة سياسة عمومية تتماشى مع التوجيهات الملكية وتستجيب للرهانات الاستراتيجية للجالية المغربية.
وفي نفس السياق، يظل العامل البشري أحد أبرز مواطن الضعف في المنظومة القنصلية، نتيجة غياب رؤية واضحة لتدبير المسارات المهنية للأطر الدبلوماسية والقنصلية. فغياب التخصص في الحركية المهنية يؤدي إلى خلط بين البروفيلات الموجهة للعمل القنصلي وتلك الموجهة للعمل الدبلوماسي، دون مراعاة طبيعة المهام المختلفة أو الحاجات المجالية للجالية. ويترتب عن هذا الوضع خلل في التوزيع الجغرافي للأطر القنصلية، إذ لا تزال الخريطة القنصلية تعكس نظرة تقليدية تعتبر أوروبا الوجهة الأساسية للمغاربة، في حين أن ديناميات الهجرة الجديدة باتت توجه أعداداً متزايدة إلى فضاءات أخرى مثل بلدان الخليج العربي، وجنوب شرق آسيا، وإفريقيا جنوب الصحراء، بل وحتى بعض بلدان أمريكا اللاتينية.
إن هذه الفجوة في مواكبة التحولات المجالية للهجرة المغربية تضعف فعالية الأداء القنصلي، وتؤثر في قدرة المغرب على الاستجابة لحاجيات جاليته وفقاً لتوزيعها الواقعي. ورغم الجهود التي بُذلت في السنوات الأخيرة على مستوى تطوير البنيات التحتية، ورقمنة جزء من الخدمات، وتشجيع الإدارة عن بُعد، وإطلاق مبادرات مبتكرة مثل “القنصليات المتنقلة”، فإن وتيرة الإصلاح لا تزال بطيئة، ولم تصل بعد إلى مستوى التحديات المطروحة.
إن التفسير النقدي لهذا التأخر يكمن في استمرار منطق المقاربة الكلاسيكية التي تركز على الجانب الإداري التقني، بدل الانتقال إلى مقاربة استراتيجية ترتكز على التخطيط الاستباقي، وإعادة انتشار الخريطة القنصلية بشكل ديناميكي يتناسب مع التحولات السوسيوديمغرافية لمغاربة العالم. ومن دون هذا التحول، ستبقى الجهود المبذولة، رغم أهميتها، دون أثر ملموس على ثقة الجالية وجودة الخدمات المقدمة لها.
اختلالات بنيوية في السياسة العمومية الموجّهة لمغاربة العالم
- محدودية جودة الخدمات الإدارية بأرض الوطن:
ظل جودة الخدمات الإدارية بأرض الوطن إحدى النقاط الأكثر حساسية في علاقة الجالية المغربية بالدولة، لكونها تمس مباشرة الجيلين الأول والثاني، الذين ترتبط قضاياهم بملفات معقدة لدى مؤسسات متعددة: (قطاع العدل، الجمارك، الضرائب، المحافظة العقارية، والجماعات الترابية. وتتنوع هذه الملفات بين نزاعات عقارية، مراجعات ضريبية، تغييرات في التصاميم، أو إشكالات التزود بالخدمات الأساسية من ماء وكهرباء)، فضلاً عن الصعوبات الناجمة عن تعقيد المساطر الإدارية وغموضها بالنسبة لأفراد الجالية.
وقد شكّلت مبادرة «الشباك الإداري المتنقل بالخارج» سنة 2019 محطة متميزة في هذا المجال، حيث أتاحت لأول مرة تقريب الإدارة المغربية من مواطنيها المقيمين بالخارج، عبر إرسال وفود تضم ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية إلى بلدان الإقامة (إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، ساحل العاج). وقد لقيت هذه التجربة استحساناً كبيراً من طرف الجالية، ليس فقط لأنها سهّلت معالجة ملفات عالقة، بل لأنها مكنت ممثلي الإدارات من الاطلاع المباشر على طبيعة الصعوبات التي يواجهها المواطنون في الخارج.
غير أن التوقف المفاجئ لهذه المبادرة عقب التعديل الحكومي لسنة 2019، الذي أدمج قطاع الجالية في وزارة الخارجية، حال دون استمرارية التجربة وتراكم مكتسباتها. وهكذا ضاعت فرصة ثمينة لبناء آلية مستدامة للتواصل الإداري، الأمر الذي عمّق فجوة الثقة بين الجالية ومؤسسات الوطن الأم. فالقرار كشف عن محدودية الرؤية الحكومية في استشراف حاجات مغاربة العالم، وأعاد إنتاج الاختلالات نفسها المتعلقة بصعوبة ولوج الخدمات الإدارية، وهو ما يؤثر سلباً في شعور الانتماء ويضعف الروابط مع الأجيال الصاعدة.
إن هذا المثال يبرز بوضوح أن غياب الاستمرارية المؤسساتية، وارتباط السياسات بالمبادرات الظرفية، من أهم العوائق التي تحول دون ترسيخ سياسة عمومية مندمجة للجالية، قادرة على بناء الثقة وتجديد الصلة بين الدولة ومواطنيها بالخارج.
– تغييب الشأن الثقافي والهوياتي:
يمثل الشأن الثقافي والهوياتي إحدى الركائز الجوهرية في صيانة روابط الأجيال الجديدة من مغاربة العالم بوطنهم الأم، غير أن الحصيلة تكشف عن تعثر واضح في هذا المجال. فرغم ما خصصته المملكة من إمكانيات مالية مهمة لتشييد مراكز ثقافية وإنشاء دور «دار المغرب» بعدد من بلدان الإقامة، فإن الوظيفة الفعلية لهذه المؤسسات لا تزال محدودة للغاية. فبعضها شُيّد منذ سنوات دون أن يدخل طور الاشتغال، رغم ما يلتهمه من اعتمادات مالية سنوية للتسيير والصيانة، في مفارقة صارخة بين حجم الاستثمار وضعف المردودية الميدانية.
كما أن المراكز التي بدأت نشاطها بشكل تشاركي تعاني اليوم من غياب تقييم موضوعي يقيس مدى إشعاعها وتأثيرها الفعلي في تقوية الهوية المغربية بالخارج. وفي الوقت الذي توجد فيه مناطق جغرافية جديدة تعرف تزايداً ملحوظاً في أعداد الجالية – خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية – فإنها تبقى محرومة من مثل هذه المبادرات، ما يعكس محدودية التخطيط الاستراتيجي في توزيع الجهود.
كما يلاحظ التراجع الحكومي منذ 2021 عن مجموعة من البرامج الثقافية والتربوية السابقة، والاكتفاء ببرنامج وحيد هو «الجامعات الصيفية» الذي خُفض بدوره عدد المستفيدين منه، يعكس نظرة تقزيمية لملف بالغ الأهمية في ربط الأجيال الناشئة بهويتهم المغربية. وفي المقابل، نص النموذج التنموي الجديد على مقترح طموح يتمثل في إحداث وكالة مغربية للعرض الثقافي بالخارج، غير أن الحكومة تأخرت في تفعيل هذا الورش، رغم إقرارها العلني بأن النموذج التنموي يمثل مرجعيتها الأساسية.
هذا التعثر يكشف عن مفارقة صارخة: فبينما تعلن الدولة عن خيارات استراتيجية لتعزيز الحضور الحضاري للمغرب في الخارج، يظل التنزيل الحكومي بطيئاً، محكوماً بمقاربات قطاعية ظرفية، ما يضعف إشعاع الهوية الوطنية، ويهدد بترك فراغ تستغله ثقافات بديلة في تشكيل وعي الأجيال المغربية الجديدة في المهجر.
إن تقوية البعد الثقافي والهوياتي الموجه للجالية المغربية بالخارج يمثل مدخلاً استراتيجياً لتجديد الروابط الوطنية وتعزيز إشعاع المغرب على المستوى الدولي. فمواصلة فتح وتفعيل المراكز الثقافية بالخارج من شأنه توحيد الجهود المؤسساتية وتوفير فضاءات للتعريف بالموروث المغربي الغني في أبعاده العمرانية والروحية والفنية، سواء لفائدة الأجيال الجديدة من أبناء الجالية أو للباحثين والمهتمين في مجتمعات الاستقبال.
وتستمد الثقافة المغربية أصالتها من أكثر من اثني عشر قرناً من التلاقح الحضاري بين مكونات بشرية وثقافية متعددة، تجسّد قيم العيش المشترك في امتداداتها الأمازيغية والعربية والعبرية والأندلسية والحسانية، فضلاً عن روافدها الإفريقية والمتوسطية. هذا التنوع يشكل رأسمالاً رمزياً يعزز مكانة المغرب كفضاء حضاري متميز. ويبرز هذا الغنى بشكل جلي في المكون اليهودي للجالية المغربية بالخارج، الذي يعد محوراً أصيلاً في الهوية المغربية، بحضوره الجيلي والجغرافي الممتد في مختلف بلدان الاستقبال.
إن تكثيف الجهود في هذا المجال لا يمثل مجرد استجابة لحاجات ثقافية، بل هو استثمار في تعزيز مكانة المغرب ضمن منطق «الدبلوماسية الثقافية الناعمة»، بما يتيح له التموقع كفاعل مؤثر في المشهد الدولي. غير أن ذلك يظل رهيناً بانتقال الحكومة من منطق المبادرات القطاعية المحدودة إلى تبني برنامج ثقافي مندمج، يقوم على التنسيق بين وزارة الثقافة وقطاع الصناعة التقليدية والسياحة، والمراكز الثقافية بالخارج، والتمثيليات الدبلوماسية. وحده هذا التنسيق كفيل بتمكين المغرب من تأطير الأجيال الثالثة والرابعة من أبناء الجالية، وترسيخ ارتباطهم بهويتهم الأصلية، وفي الآن ذاته توسيع دائرة إشعاعه الحضاري في الخارج.
- تفاعل حكومي لا يرقى إلى مستوى الطموح:
تظهر التجربة العملية أن تدبير قضايا الجالية المغربية بالخارج ما زال يعاني من اختلالات بنيوية تمسّ ثلاثة مستويات مترابطة. أولها، محدودية جودة الخدمات الإدارية المقدمة داخل أرض الوطن، حيث تتسم بالبطء وتعقيد المساطر وغياب قنوات فعّالة للتواصل والمتابعة، وهو ما يجعل قضايا بسيطة تتحول إلى مصدر إرباك وإحباط، ويضعف ثقة المهاجر في مؤسساته الوطنية.
وثانيها، غياب سياسة ثقافية مندمجة تواكب التوسع الجغرافي لأبناء الجالية وتنوع أجيالهم. فالمبادرات المعلن عنها لم تتحول إلى أدوات فعلية لترسيخ الانتماء، بل بقي تأثيرها محدودًا في مجالات محددة، بينما ظلت مناطق ذات كثافة هجرية متزايدة خارج أي مخطط منظم، وهو ما يترك فراغًا تستغله ثقافات بديلة في التأثير على وعي الأجيال الصاعدة.
أما المستوى الثالث فيتجسد في المقاربة الحكومية ذاتها، حيث ظل التعاطي مع الملف حبيس منطق تدبيري ضيق، يفتقد إلى رؤية استراتيجية شاملة، ما ساهم في تقليص فعالية القطاع بدل تطويره. فالبرامج القائمة افتقرت إلى الاستمرارية، والموارد المرصودة لم تُترجم إلى نتائج ملموسة، في وقت يتطلب فيه الملف دينامية جديدة تعكس مكانة الجالية باعتبارها رصيدًا استراتيجيًا في الحاضر والمستقبل.