«إذا طلب مني المساهمة، لن أقول لا لنداء الجزائر»، ذلك ما أكده الديبلوماسي الجزائري المحترم، الأخضر الإبراهيمي مساء الأربعاء 13 مارس 2019، للتلفزيون الجزائري (القناة الثالثة) في لقاء مباشر معه، جوابا عن سؤال إذا كان قد كلف بمهمة رسمية لتدبير الحوار الوطني الموسع، المنتظر تنظيمه بعد الحراك الكبير الذي تشهده البلاد. مؤكدا بشكل جازم، أنه لا يمكن، في ما معناه، وضع العربة قبل الحصان، نافيا أن يكون قد كلف رسميا بذلك، وأنه يجب انتظار التئام أشغال ندوة الحوار الوطني الموسع (كمؤتمر مفتوح) ليختار المتحاورون من يكون رئيسا لذلك اللقاء الوطني.
الحقيقة، أن الرجل بديبلوماسيته المعهودة وكفاءته السياسية المجربة، إنما أراد أن يوجه رسالة واضحة مفادها أنه لن يقبل أن يفرض نفسه على أحد، وأنه إذا طلب منه المساهمة للبحث عن حلول بدافع الواجب الوطني، رغم ظروفه الصحية وتعب السنين (85 سنة)، فإنه لن يتراجع أمام «نداء الجزائر». وهذا صوت حكمة، يعتبر اليوم رأسمالا مهما عند جيراننا الأشقاء، أمام لحظة التدافع الحامية، غير المسبوقة، منذ الإستقلال سنة 1962، التي تصنعها الأجيال الجديدة هناك، والتي تقدم الملامح الكاملة على تبرعم ملامح «الجمهورية الثانية بالجزائر». بل، إنه لربما، من حظ الإخوة الجزائريين، أن يكون من بينهم صوت سياسي مجرب من قيمة الأستاذ الأخضر الإبراهيمي، الرجل الذي خبر أزمات دولية عدة، ونجح في إيجاد حلول ناجعة للكثير منها كمبعوث أممي (خاصة في لبنان)، في مقابل امتلاكه جرأة إعلان استحالة التوصل لحلول في ملفات أخرى (مثل الملف السوري). بالتالي، فالرجل عادة من يزرع الكثير من أسباب الأمل كلما انخرط في ملفات غارقة في اليأس، من أجل إبداع حلول سلمية لها. فهو بهذا المعنى طاقة كبرى للأمل، وذلك هو ما يرمز إليه ببلده الجزائر اليوم.
لهذا السبب، فهو الوحيد الذي امتلك جرأة أن يقول في ذلك الحوار: «لست شاهد زور، رغم كل ما قيل في حقي من افتراء وكذب» و «إن التغيير الجدري مطلوب ومشروع» وأن الحكمة بالنسبة له هي في إبداع الحلول بالتوافق من خلال مكرمة الحوار. لأنه بالنسبة له ف: «التظاهر يشير إلى المشاكل، ينبه إليها، لكنه لا يحلها»، وأن «التواصل يخلق أجواء إيجابية للتلاقي وبلورة الحلول» بروح التوافق، تأسيسا على الحكمة الفرنسية التي تفيد أن «الأجود عدو الجيد»، لأن الإكتفاء بمجرد التموقع للوصول إلى «الأجود» إنما يمنع «الجيد» من التحقق، الذي هو مقدمة ضرورية للوصول إلى المرتجى. والمقصود هنا، بالنسبة للرجل، هو أن نبل الأفكار (أي مطالب التغيير وحلم الجمهورية الثانية بدستور جديد)، يقتضي الحوار الجماعي لإبداع طرائق تنفيذ ذلك. معتبرا أن مطلب المجلس التأسيسي الذي ظل يطالب به الراحل الحسين آيت أحمد منذ الإستقلال، وتعيد طرحه اليوم السيدة لويزا حنون، إنما يجد ترجمته في مأسسة الحوار الوطني من خلال رزنامة زمنية واضحة.
هذا كله يقدم الدليل، على أن المنتظر من أدوار للإبراهيمي في القادم من الأيام بالجزائر كبير وكبير جدا، رغم كل التشويش الذي يحاول البعض بثه هنا وهناك. ولم يسجل في أي من مظاهرات الشارع الجزائري ما بعد قرارات الرئيس المنتهية ولايته الرابعة عبد العزيز بوتفليقة، أن رفع شعار ضده، يطعن في وطنيته ونزاهته. لهذا السبب، فإن معنى أن يتم بث خبر استقباله من قبل الرئيس بوتفليقة ضمن نشرات الأخبار الرئيسية بالتلفزيون الجزائري، بالتوازي مع لحظة إعلان القرارات السبعة ليوم الأحد الماضي، وإقالة حكومة أويحيى (الذي أبان عن انعدام كبير للذكاء السياسي في شكل التعامل مع قوة مطالب الحراك الشعبي)، وتعيين رئيس جديد للحكومة ونائب له، وعقد لقاء مع قائد الجيش الجنرال قايد صالح، فإن الرسالة البرتوكولية والسياسية هنا واضحة. أي أن الأخضر الإبراهيمي، رجل مطلوب منه اليوم لعب دور، كقوة إيجابية، تحظى بالإحترام والثقة من كل الأطياف بالجزائر، لتيسير الإنتقال الديمقراطي عند أشقاءنا، تأسيسا على الدروس الكبيرة المستخلصة من السنوات الصعبة للتسعينات، وأيضا من نتائج الأخطاء التدبيرية في معالجة مطالب الإصلاح والتغيير بعدد من البلاد العربية (خاصة سورية وليبيا).
هل ستكون المهمة تلك سهلة؟
المهام التاريخية الكبرى، لا تكون كبيرة سوى لصعوبتها وتحدياتها، وهي امتحان لذكاء رجال الدولة من طينة الأستاذ الأخضر الإبراهيمي، الرجل الذي خبره المغاربة كثيرا، على كافة المستويات، سواء في الدولة أو في النسيج الحزبي الوطني والتقدمي، كرجل مبدأ مغاربي رفيع المقاربات. وأنه حين تكون مغالق الحسابات السياسية دون طموحه، يستكين إلى منطق عدم الإساءة والتطاول، من خلال عفة لسانه البليغة دوما، حين كان في مرحلة من المراحل وزير خارجية بلاده، في مرحلة جد دقيقة هناك (1991/ 1993)، التي كانت بداية للأزمة السياسية الخطيرة التي عصفت بالبلاد وأدخلتها في ما أصبح يعرف ب «العشرية السوداء». فلم يحدث أن سجل عليه موقف معيب أبدا تجاه بلادنا، بل على العكس من ذلك، يسجل له التاريخ مواقف جريئة في الكثير من المواقف الداعمة لرؤية المغرب في بعض الملفات العربية (مثل ملف لبنان).
إن الرجل يصدر في ذلك، في الحقيقة، عن قناعة مغاربية أصيلة، وعن قراءة ذكية دوما (صريحة ومسؤولة) لتعقد واقع التدافعات بمنطقتنا. لقد أكد لي منذ ثلاث سنوات، في حوار معه، نشر في نونبر 2015، بيومية «الإتحاد الإشتراكي»، قائلا:
«أقول لك، بكل صراحة، أنه رغم عيوبنا الكبيرة ومشاكلنا البينية، وكيفية معالجتنا لها، التي ليست في مستوى ما نتمناه.. رغم كل ذلك، فحالنا بالمغرب العربي أحسن بكثير من وضع المشرق العربي.
بالتالي، علينا الآن في المغرب العربي الكبير واجب مضاعف. واجب نحو أنفسنا أولا، لأنه غير معقول ولا مقبول أن يبقى هذا الجفاء بيننا، مما يجعل تعاوننا شبه معدوم. ثم علينا مساعدة إخوتنا في المشرق، مادام وضعنا أقل سوءا من وضعهم، وهذا ربما سيدفعنا بقوة الأشياء ليكون أداؤنا مغاربيا أحسن مما هو عليه الآن».
هذه القناعة، هي نفسها التي يظل الرجل يدافع عنها، في اللقاءات الخاصة واللقاءات العامة، والتي تجعله لا يتردد أبدا في أن يستجيب، مثلا، لدعوات المشاركة في لقاءات عمومية بالمغرب، من قبيل إحياء الذكرى 50 لاختطاف الشهيد المهدي بنبركة، الذي كان آخر مسؤول ديبلوماسي وسياسي التقاه 48 ساعة قبل اختطافه رحمه الله بباريس، حيث استضافه في عشاء مطول ببيته بالقاهرة بصفته سفيرا للجزائر بمصر حينها، وأنه هو من نقله في سيارته إلى المطار ليلة 27/ 28 أكتوبر 1965. وكذا مشاركته في حفل تقديم مذكرات الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي بمسرح محمد الخامس بالرباط منذ أشهر قليلة، حيث شارك فيها بكلمة رفيعة وبليغة، إلى جانب الزعيم الإشتراكي الإسباني فيلليبي غونزاليس والمناضل الحقوقي المصري محمد فايق. وهي المشاركات التي كان يستجيب فيها دوما لدعوات رفيقه وصديقه الكبير الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، فكلاهما، يقدمان عناوين أمل مغاربية كبيرة.
هل سيكون الإبراهيمي هو عبد الرحمن اليوسفي الجزائر؟
في مكان ما، لا يمكن للمرء إلا أن يتساءل، جديا، إن لم يكن الرجل فعلا منذورا للعب ذات الدور، الذي لعبه القائد الإتحادي الكبير بالمغرب، بوازع وطني، رغم ظروفه الصحية وسنه، حين قبل المساهمة في إنقاذ البلاد من «السكتة القلبية» التي نبه لها الملك الراحل، المرحوم الحسن الثاني.
كل المعطيات الخاصة والعامة، تؤكد إمكانية ذلك، وأن انخراط الأخضر الإبراهيمي، بقوة في المشهد العام الجديد بالجزائر الشقيقة، يقدم ما يكفي من الأدلة أن بصمته ستكون وازنة ومؤثرة، تأسيسا على مصداقيته ونزاهته السياسية والأخلاقية هناك، وكذا دربته الرفيعة في مجال تغليب الحلول السلمية للأزمات. ولعل من العناوين الكبرى على ذلك، دعوته في الحوار المباشر الذي أجرته معه القناة التلفزية الرسمية بالجزائر، إلى عقد مؤتمر وطني، بغاية مأسسة حوار يرسخ مكرمة إنصات الجزائريين لبعضهم البعض وإقناع بعضهم البعض. مشددا على أن نقط التلاقي اليوم بين الجميع كامنة في أنهم جميعا أبناء للجزائر كوطن، وأنهم مجمعون على ضرورة التغيير الجذري (أي الجدي) والتأسيس للجمهورية الثانية. وأن الإختلاف (الطبيعي والعادي) كامن في شكل وطريقة تنفيذ نقط التلاقي هذه، وهو ما يتطلب واجب الحوار الوطني المسؤول، برزنامة زمنية وسياسية مدققة.
إن قوة الأخضر الإبراهيمي، آتية أكيد من صلابة تاريخه الوطني الخاص، ومن تراكم تجربته الديبلوماسية، ومن نزاهته الأخلاقية والسياسية، هو الذي تشرب أسس ذلك كله من تربيته العائلية الأصيلة والعريقة، منذ رأى النور سنة 1934 بمنطقة المدية (بلدة العزيزية)، التي هي الشقيقة الكبرى حضاريا وثقافيا لتلمسان، كونهما تشتركان معا في الإرث الحضاري الأندلسي مغاربيا. وأنه من جيل الحركة الوطنية الجزائرية، الذي امتاز بامتلاكه باكرا ناصية العلوم الحديثة، كونه كان من قادة التنظيمات الطلابية الجزائرية في بداية الخمسينات، هو الذي درس القانون والحقوق والعلوم السياسية بجامعة الجزائر ثم بفرنسا. وأيضا كونه من قادة الإضراب الشهير للطلبة الجزائريين يوم 19 ماي 1956، بسبب أنه من مؤسسي وقادة «الإتحاد العام للطلبة المسلمين بالجزائر». مما مكنه باكرا، أن يكون رسولا للثورة الجزائرية ولحكومتها المؤقته، في العديد من عواصم العالم، خاصة بدول الهند الصينية (قضى بالعاصمة الأندونيسية «جاكرتا» 6 سنوات كاملة ممثلا للثورة الجزائرية ما بين 1956 و 1961). مما خوله أن يعين بمجرد استقلال الجزائر سنة 1962، سكرتيرا عاما لوزارة الخارجية الجزائرية، على عهد الرئيس أحمد بنبلة، قبل أن يتم تعيينه سفيرا لبلده بمصر سنة 1965، بعد الإنقلاب الذي قاده المرحوم هواري بومدين، في شهر يونيو من ذات السنة. ليواصل مسيرته الديبلوماسية دوليا، أي خارج بلده، إما كمبعوث للجامعة العربية أو كمبعوث للأمم المتحدة، مع فترة قصيرة عين فيها وزيرا للخارجية لبلده لم تتعد السنتين بين 1991 و 1993.
الأخضر الإبراهيمي، الذي يتقن 4 لغات، المتحدث بطلاقة بالقبايلية الجزائرية الأمازيغية، الهادئ جدا بطبعه (كبودي مثله مثل رفيقه وصديقه عبد الرحمن اليوسفي)، هو ورقة أمل كبيرة بالجزائر الشقيقة، سيكون له أكيد أثر إيجابي في مصاحبة التحول المنتظر هناك. أي التحول الإصلاحي، بدستور جديد، بآلية سياسية تدبيرية جديدة، عنوانا لملامح جمهورية ثانية بعد جمهورية 1962. أي الإنتقال من «دولة جيل الحركة الوطنية» إلى «جيل دولة المؤسسات والحق والقانون». وأن ذلك كله لا يمكن إلا أن يكون باب أمل لميلاد مغرب كبير بدوله القوية بمؤسساتها الديمقراطية.
وعد مغاربي يكاد المرء يراه قادما بأمل في القادم من الشهور، مركزه الصلب تجويد العلاقات بين الرباط والجزائر العاصمة.

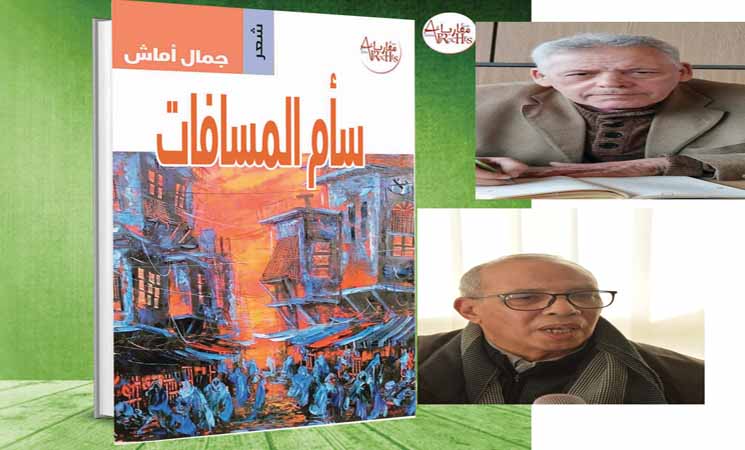




اترك تعليقاً