بعد الحوار الذي أنجزناه مع المفكر والكاتب عبد الإله بلقزيز في صيف 2015 بجريدة الاتحاد الاشتراكي، وفي تقديمنا لهذا الحوار التزمنا مع المفكر وقراء الجريدة أن الحوار سيكون في ثلاثة محاور رئيسة: وهي الأدبي، والسياسي، والفكري. في صيف 2015 كان الحوار أدبياً وذاتياً. أما اليوم فإننا نطرق بوابة السياسي في إنتاج هذا المفرد بصيغة الجمع. انطلاقاً من كتاباته السياسية التي تدخل ضمن مشروعه النظري والفكري العام؛ حاولنا مشاكسته في بعض القضايا السياسية في راهننا العربي: فلسطين، العولمة، الديمقراطية، الدولة، المعارضة، ثم الخطاب القومي، والربيع العربي، وغيرها كثير.
كلما اقتربت من عبد الإله بلقزيز إلاّ وازداد حباً وتقديراً؛ فهو المبدئي الذي لا يفرط في مبادئه، مهما كان الثمن، يدافع عن مشروعه القومي باستماتة فارقة. فالمتتبع لأعماله سيصل، بالضرورة، الى هذه التقدمية، والحداثية في إنتاجه الفكري، وممارسته المهنية، وانخراطه في الجبهات المناهضة للعولمة والامبريالية… بل أكثر من ذلك فكتاباته السياسية تستشرف المستقبل، ليس لأنه يؤسس نظره على الفكر السياسي، والحداثي، والفلسفي، وإنما في انخراطه الكلي في قضايا العالم العربي. نفتح هذا الحوار لنتقرب من هذا الرجل أكثر؛ الرجل الذي يُحيط زائره بالحبّ والتقدير والكرم. نقول له شكرا لأننا اخترقنا عالمك، وفتحت لنا قلبك للحديث عن أوجاعنا، ومطبّاتنا، وأعطابنا السياسية والتاريخية.
وأقول شكراً للصديق محمد رزيق الذي شاركني في إنجاز هذا الحوار، والشكر موصول الى الاصدقاء الذين قاموا بتفريغ الحوار وكتابته (الإخوة محمد البوقيدي، محمد زكاري، إبراهيم وانزار). أملنا في أن يكون هذا الحوار إطلالة على الجوانب المهمة من فكر هذا الرجل.
o بين شرعية محمد مرسي ومشروعية عبد الفتاح السيسي: ألا يمكن اعتبار هذا النزوع نحو الدفاع عن الشرعية هو عودة المكبوت الإخواني أو العسكري معاً؟
n أولا؛ أنا لست من القائلين إنّ ما حصل في 25 يناير 2011م ثورة وما حصل في 3 يوليوز 2013م انقلاب عسكري، لسبب كتبت فيه وحلّلته في مناسبات كثيرة. إنّ الذي أزاح محمد حسني مبارك من السلطة يوم 11 فبراير 2011م ليس ميدان التحرير ولا المتظاهرين، أو، حتى أكون مُنصفاً، ليس المنتفضون وحدهم؛ الذي أزاحه شريكان: الجماهير المنتفضة في ميدان التحرير وسواهما من ميادين القاهرة، و»المجلس الأعلى للقوات المسلحة». هذا الأخير هو مَن طلب من مبارك رسمياً التنحي عن منصب الرئاسة، وهذه باتت من الحقائق المعروفة، فأُجبر مبارك على يقرأ خطاب التنحي نائبه عمر سليمان، الذي كان قائد المخابرات العامة سابقاً. بل أستطيع أنْ أضيف، لو لم يتدخل «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» في مصر لإزاحة مبارك، لربما كان شباب ميدان التحرير ما يزالون معتصمين حتى الآن في الميدان. إذاً فما نسميه بالثورة المصرية هو شراكة بين مؤسستين: بين الشعب وبين الجيش. نفس الشراكة هي التي ستحصل في إزاحة محمد مرسي؛ حصلت انتفاضة لا سابق لها، في 30 يونيو 2013، في أقصى التقديرات كان يُعتقد أن المنتفضين في 25 يناير 2011م، قد تزيد أعدادهم أو تقل عن 8 ملايين. ولكن التقديرات الغربية، قبل المصرية، قالت إنّ الذين خرجوا قبل 30 يونيو لا يقلون عن 18 إلى 21 مليون؛ أي ثلاثة أضعاف العدد الذي انتفض في ما سمي بثورة 25 يناير. كان هذا الشريك الأول الذي هو المجتمع، وعلى رأسه حركة «تمرُّد» الشبابية، ثم تدخلت القوات المسلحة. كيف تدخّلت؟ كان في ذلك الحين، اللواء عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، قد طلب من محمد مرسي،باسم الاقوات المسلحة، الاستجابة لمطالب الحركة الشعبية في غضون يومين. لم يأبه محمد مرسي لضغوط وزير الدفاع، وتحدى الجميع وركب رأسه، وكانت النتيجة أنّ الجيش سيطر على القصر الجمهوري والمؤسسات الرسمية، بُعَيْد انتفاضة يونيو، ثمّ وُضع إخراج مناسب ليس كما حصل في 11 فبراير. ففي هذا التاريخ (أي 11 فبراير 2011)، ألقى عمر سليمان خطاب تنحي الرئيس، وأعلن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» بأنه سيستلم مهمات الرئاسة لمرحلة انتقالية إلى حين انتخاب رئيس جديد. أما في 3 يوليوز 2013 فلم يحصل ذلك، لم يأت وزير الدفاع ليقول إنّ «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» سيستلم السلطة إلى حين، وإنّما عُقِد اجتماع وطني حاشد هو الاجتماع الذي أعلن تنحية محمد مرسي، شارك فيه الجيش، ممثلا بوزير الدفاع، والأزهر ممثلاً بشيخ الأزهر، والكنيسة القبطية ممثلة بالبابا، «جبهة الإنقاذ الوطني» ممثلة بأمينها العام محمد البرادعي، وحركة «تمرد» ممثِّلَة الشباب (وكانت، في آخر عهد مرسي قد جمعت قرابة 25 مليون توقيع تطالب بتنحيه عن السلطة)، ثم شاركت المرأة من خلال الكلمة التي ألقتها الأديبة السيدة سكينة فؤاد (التي سبقت وكتبت سيناريو مسلسل «ليلة القبض على فاطمة» الشهير). إذاً المجتمع كله كان هناك في جلسة رسمية أمام الإعلام الدولي، وكل فريق ألقى كلمته، ثم أعقب ذلك اتخاذ قرار بتشكيل حكومة انتقالية ورئيس انتقالي، وكان الرئيس الانتقالي هو رئيس المحكمة الدستورية، السيد عدلي منصور، وليس عبد الفتاح السيسي أو رئيس «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» ، ثم تشكلت حكومة انتقالية وبدأ المسلسل نحو انتخابات تشريعية ثم فيما بعد رئاسية.
هذا حدث نعتبره ثورة باسم ثورة 25 يناير ينتهي بسيطرة العسكريين على السلطة وبقبول المدنيين ذلك؛ حيث وافقوا على أنْ يتسلّم «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» منصب الرئاسة لفترة انتقالية امتدّت لثمانية عشر شهراً كان الحكم فيها عسكرياً. أما بعد ثورة 30 يوليوز فكانت الحكومة مدنية، وكان الرئيس الانتقالي مدنياً، ولم يأت عبد الفتاح السيسي إلى السلطة إلا بعد أنْ تخلّى عن صفته العسكرية، وترشّح كمدني ووصل إلى السلطة محمولاً على صهوة شعبيته الهائلة التي حصل عليها في مواجهة سلطة محمد مرسي على الرغم من أنه كان مغموراً لا أحد يعرفه؛ حتى محمد مرسي نفسه كان لا يعرفه، كان يعتقد أنّه هذا محسوب على الإسلاميين، لأنّ أحد أقاربه –كما قيل – كان من قادة «الإخوان المسلمين» في الخمسينيات، ولأنّ التقارير، التي وصلت مرسي، تقول عنه إنّه رجل يصلي ويتقي الله…إلخ. هكذا وافق مرسي على أن يكون وزير دفاع. وفجأة تحول هذا الرجل إلى رمز بالنسبة إلى المصريين. فإذاً، لا قياس مع الفارق؛ ما تعتبره ثورة يمكن لأي شخص أنْ يعتبره انقلاباً أو على الأقل نصف ثورة ونصف انقلاب، وما تعتبره انقلاباً يمكن للكثيرين أن يعتبروه ثورة، وأنّ كل ما فعل الجيش فيها هو أنه تجاوب مع مطالب الشعب وأقصى محمد مرسي. والأهم في ذلك كله، في ما أتصور أنا، وقلت هذا الكلام لأصدقاء كثيرين في مصر، بمن فيهم من رُشّحوا للرئاسة مثل الصديق حمدين صباحي، وهو صديق حميم، قلت: إنّ المصريين يعبدون الله، ولكنهم يعبدون الدولة أيضا؛ فهي قديمة في الوجدان المصري منذ سبعة آلاف عام. ولقد وُضِع المصريون في لحظةٍ من التاريخ الحديث أمام أمرين: «الجماعة» أو «الدولة»؛ والسبب هو أن فترة السادات ومبارك جففت ينابيع الحياة السياسية في مصر: صفّت الناصريين، والشيوعيين، والليبيراليين…القوى السياسية كافة، ولم تترك من كائن سياسي في مصر عدا «الإخوان المسلمين»، وحينما جاء المصريون ليحاسبوا حقبة سياسية لم يجدوا غير عنوان سياسي واحد هو «الإخوان المسلمين»، ولربما وثقوا فيه للحظة قبل أن يتأذوا منه، فوجدوا أنفسهم أمام خيارين: إما الجماعة أو الدولة؛ جرّبوا الدولة لسبعة آلاف عام وضمنت لهم الاستقرار والماء والخبز، وجرّبوا الجماعة لعامين فأصابهم منها ما أصابهم، فانتصروا للدولة على الجماعة أياّ يكن ذلك الذي يمثل الدولة.
ولكن هناك درس آخر من هذا الموضوع كله تُطلعنا عليه التجربة المصرية ومضمونه أنّ الدولة مطلب اجتماعي في مجتمعاتنا. مجتمعاتنا هشّة يزيدها تهشيشاً ضَعْفُ الدولة وفقدانُها سلطانها وهيبتها من قِبل أولئك الذين ينالون من تلك السلطة والهيبة مثل: الطوائف، والقبائل، والعشائر، أو الجماعات الأصولية… كلما اضمحلّ نفوذ الدولة من المجتمع، نجم من ذلك انفجار المجتمع! حصل هذا في لبنان، حصل في السودان وفي العراق بعد تدمير الدولة الوطنية، وفي ليبيا، ويحصل في سورية، وفي اليمن. كان يراد لمصر أنْ يحصل فيها ما يحصل في هذه البلدان تماماً كما كان يراد لتونس، ولكن من حسن حظ مصر وشعبها، وتونس وشعبها أنّه قطع الطريق على هذه المؤامرة فاحتفظ بالدولة، وبالتالي احتفظ بوحدة المجتمع والكيان. وما تزال المعركة مفتوحة اليوم مع هذا الكيان الوطني عبر التفجيرات الإرهابية للكنائس والمساجد وغيرها لإيقاع الفتنة الداخلية في صفوف أبناء الجماعة الوطنية الواحدة. وأضيف إليك أنّه لم تحصل حوادث الاحتكاك الطائفي في تاريخ مصر كما حدثت في حقبة محمد مرسي. هذا ما أقوله في شأن التجربة المصرية وهي التجربة الأم في ما يسمى «الربيع العربي»، إنْ كانت لنا من دروس نتّعظ بها في هذا الباب، فهي أنّ مصر بثقلها التاريخي، بخبرتها وحُنكتها، برسوخ تقاليد الدولة فيها، وهي الأقدم، باجتماع هذه العوامل كلِّها أمكنها أن تستوعب صدمتها، وأنْ تخرج منها، لا أقول معافاةً، ولكن بأقلّ الخسائر. طبعاً ما تزال تعيش تبعات وذيول ذلك الزلزال الكبير في معيشتها واقتصادها وفي أمنها المستباح من قبل الجماعات الإرهابية، لكنها مع ذلك استطاعت أنْ تستوعب هذه العاصفة، بينما بلدان أخرى، بسبب غياب العوامل التي ذكرتُ، لم تستطع أن تستوعب ذلك الزلزال، وبالتالي فهي تعيش ارتداداته حتى اليوم على الصعود كافة.
o من بين ما أفرزته الثورات العربية متوالية الثائر والناخب، وهي على العموم ما أعطى للناخب قوة في صمود الإسلاميين: هل في نظركم صعودهم في تونس، ومصر، والمغرب، مثلاً، دليل على طوباوية الثائر أم أنّ المسألة تُفيد غير ذلك؟
n لي تحفُّظ على عبارة «ثائر»؛ لأن لمفهوم «الثورة» حرمةً نظرية عندي، وليس كل من اعترض وجهر باعتراضه يُعدُّ في زمرة الثائرين. الثائر هو من لديه مشروع اجتماعي-سياسي متكامل، هؤلاء الذين انتفضوا لم يكن لديهم مشروع. لكن بحكم أنّ المزاحمة، والتنافس السياسي اليوم يجري ضمن قواعد ترسمها العملية الانتخابية، كان من الطبيعي أنّ مآل كل ما جرى أنْ ينتهي إلى الاعتراك الانتخابي، وأن تُقاس الأوزان بهذا المعيار. وقد كتبتُ، كما تعرف، في «ثورات وخيبات» منتقداً ما سمّيته بـ»الداروينية السياسية»؛ أي بالذهاب إلى المنافسة السياسية على قاعدة ثنائية الغالبية والأقلية، وقُلتُ إنّ هذه القاعدة ليست ملائمة أو مناسبة لطبيعة مرحلة الانتقال، فمراحل الانتقال تكون محكومة بقواعد أخرى غير قاعدة المنافسة الانتخابية: تكون محكومة بقاعدة التوافق. لم يحصل توافق لا في مصر ولا في تونس ولا في المغرب على مشتركات اجتماعية وسياسية، ولم تُبْنَ على هذا التوافق تفاهمات تتولد منها مؤسسات سياسية تشريعية وتنفيذية متوافق عليها. هذه مرحلة الانتقال الديمقراطي التي هي مرحلة التوافق لا مرحلة الغلبة؛ فبعد أنْ تستتبّ أمور الانتقال الديمقراطي، حينها يُمكن أنْ نذهب إلى المنافسة وإلى الغلبة وكسر الإرادة…إلخ. لقد أخذنا المسألة معكوسة، ودخلنا إلى التنافس، وأنتَ تعرف مآل ذلك في تونس، وفي مصر بصورة خاصة، وبشكل ما من الأشكال في المغرب أيضاً. لذلك أنا لا أجد صلة موضوعية بين ما سمّيتَه «الثائر» و»الناخب»: إنّ الثاني ليس امتدادا للأول؛ لأنّ «منطق الثورة» هو منطق إعادة النظر في نموذج سياسي قائم، ونظام سياسي قائم من أجل فتح الطريق للتوافق على نظام سياسي بديل، لكن الذي حصل أنّ «الثورة» أسقطت نظاماً لكنها لم تستطع بناء نظام جديد؛ لأنها توسلت نفس الأدوات التي كانت في النظام السابق فأعملتها، فكانت النتيجة هي الخراب، بينما كان المطلوب هو قواعد عمل جديدة بين الأطراف الشريكة في عملية التغيير، والقواعد الجديدة هي التوافق الذي لم يحصل. لهذا لا أرى، كما ٌقُلتُ، علاقة موضوعية بين لحظتين: لحظة التغيير ولحظة البناء، وعموماً ما يسمى ـ»الربيع العربي» مبناه كله على مفارقات، وهذه واحد منها. والمفارقة الثانية والأضخم في عملية التغيير، هو أنّ الذين أنجزوا التغيير ليسوا هم أولئك الذين يُفترض أنْ يكونوا في جملة قوى التغيير؛ أي الأحزاب والحركات الاجتماعية وغيرها، وإنما الشارع هو الذي أنجز التغيير، الشباب والقوة المدنية هم الذين أنجزوا هذا التغيير. وقد كتبتُ عن هذه المفارقة: كيف أنّ الشباب أسقطوا سلطة كانت الأحزاب عاجزة عن إسقاطها، بينما بنت الأحزاب سلطة كان الشباب عاجزين عن بنائها! وهذا ما يدعو إلى التفكير في شأننا السياسي بمناسبة هذا الذي جرى وأطلق عليه اسم «الربيع العربي».
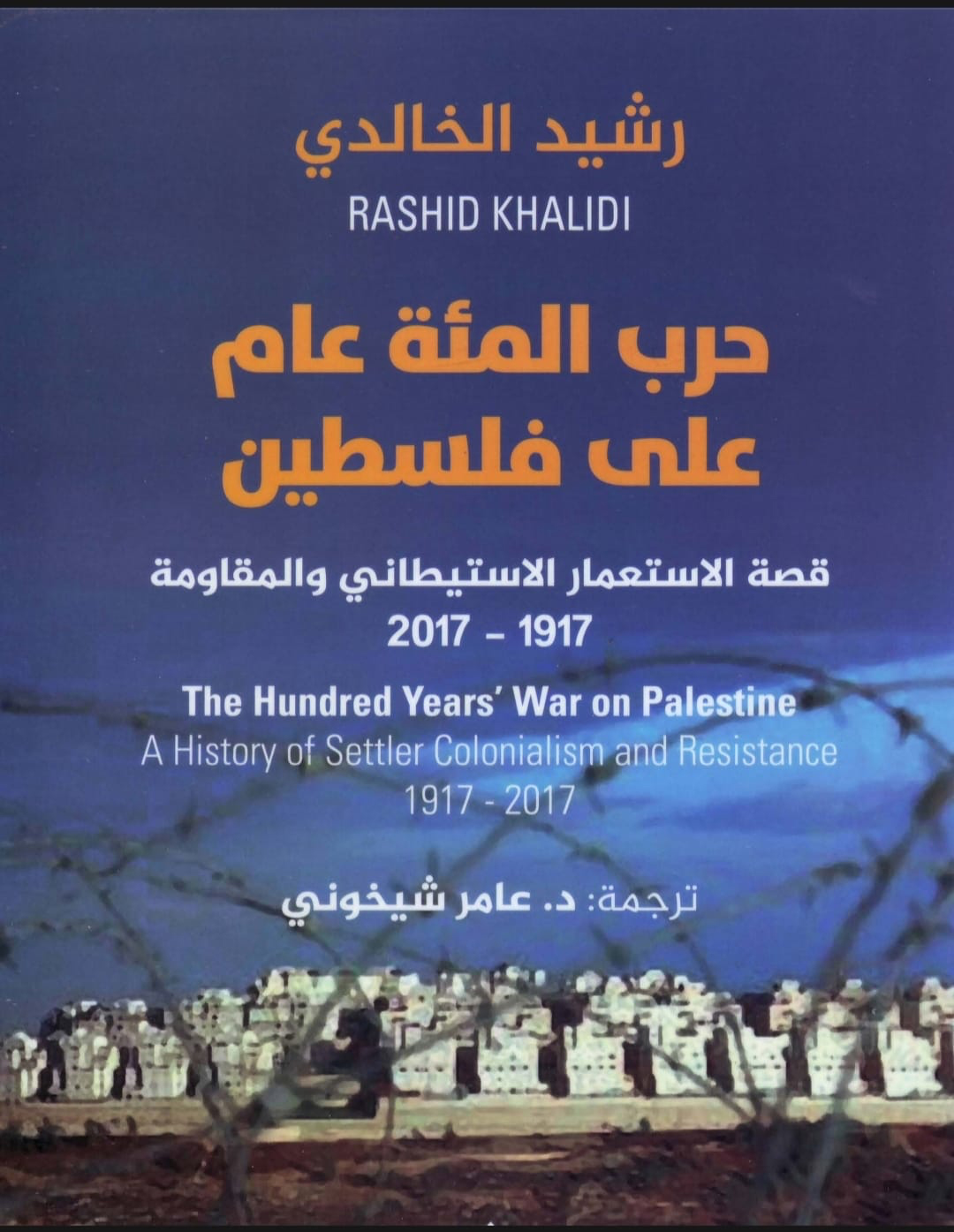




اترك تعليقاً